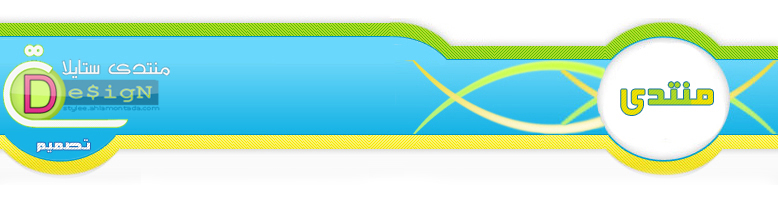ebrehim
مدير

عدد المساهمات : 2239
تاريخ التسجيل : 19/10/2011
 |  موضوع: الاستعارة المفيدة موضوع: الاستعارة المفيدة  الثلاثاء 12 يونيو 2012, 17:57 الثلاثاء 12 يونيو 2012, 17:57 | |
| اعلم أنّ الاستعارة في
الحقيقة هي هذا الضرب دون الأول، وهي أمَدُّ ميداناً، وأشدُّ افتناناً، وأكثر
جرياناً، وأعجب حسناً وإحساناً، وأوسعُ سعَةً وأبعد غَوْراً، وأذهبُ نَجْداً في
الصِّناعة وغَوْراً، من أن تُجمعَ شُعَبها وشُعُوبها، وتُحصَر فنونها وضروبها، نعم،
وأسحَرُ سِحْراً، وأملأ بكل ما يملأ صَدْراً، ويُمتع عقلاً، ويُؤْنِس نفساً، ويوفر
أُنْساً، وأهدَى إلى أن تُهدِي إليك أبداً عَذَارَى قد تُخُيِّرَ لها الجمال،
وعُنِيَ بها الكمال وأن تُخرج لك من بَحْرها جواهرَ إن باهَتْها الجواهرُ مَدَّت في
الشرف والفضيلة باعاً لا يقصرُ، وأبدت من الأوصاف الجليلة محاسنَ لا تُنكَر، وردَّت
تلك بصُفرة الخجل، ووَكَلتها إلى نِسْبتها من الحَجَر وأن تُثير من مَعْدِنها
تِبْراً لم ترَ مثلَه، ثم تصوغ فيها صياغاتٍ تُعطّل الحُلِيَّ، وتُريك الحَلْيَ
الحقيقي وأن تأتيك على الجُملة بعقائل يأْنس إليها الدين والدنيا، وفضائل لها من
الشرف الرُّتْبة العليا، وهي أجلُّ من أن تأتيَ الصفةُ على حقيقة حالها، وتستوفيَ
جملةَ جمالها، ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تُبرز هذا البيان أبداً في صورة
مُستجَدَّةٍ تزيد قَدرَه نُبْلاً، وتوجب له بعد الفضلِ فضلاً، وإنَّكَ لَتِجِدُ
اللفظة الواحدة قد اكتسبتَ بها فوائد حتى تراها مكرّرة في مواضعَ، ولها في كل واحد
من تلك المواضع شأنٌ مفردٌ، وشرفٌ منفردٌ، وفضيلةٌ مرموقة، وخِلاَبةٌ موموقة، ومن
خصائصها التي تُذكرَ بها، وهي عنوان مناقبها، أنَّها تُعطيك الكثير من المعاني
باليسير من اللفظ، حتى تُخرجَ من الصدَفة الواحدة عِدّةً من الدُّرَر، وتَجْنِيَ من
الغُصْن الواحد أنواعاً من الثَّمر، وإذا تأمَّلتَ أقسام الصَّنعة التي بها يكون
الكلام في حَدَّ البلاغة، ومعها يستحِق وصفَ البراعة، وجدتَها تفتقر إلى أن تُعيرها
حُلاها، وتَقصُرُ عن أن تُنازعها مداها وصادفتها نجوماً هي بدرها، ورَوضاً هي
زَهْرها، وعرائسَ ما لم تُعِرْها حَلْيها فهي عواطل، وكواعبَ ما لم تُحَسِّنها فليس
لها في الحسن حظٌّ كامل، فإنك لترى بها الجمادَ حيّاً ناطقاً، والأعجمَ فصيحاً،
والأجسامَ الخُرسَ مُبينةً، والمعاني الخفيّةَ باديةً جليّةً، وإذا نظرتَ في أمر
المقاييس وجدتَها ولا ناصر لها أعزُّ منها، ولا رَوْنَق لها ما لم تَزِنْها، وتجدُ
التشبيهات على الجملة غير مُعْجِبَةٍ ما لم تكُنْها، إن شئت أرتك المعانيَ اللطيفةَ
التي هي من خبايا العقل، كأنها قد جُسِّمت حتى رأتها العيون، وإن شئتَ لطَّفتِ
الأوصاف الجسمانية حتى تعود رُوحانية لا تنالها إلاّ الظنون، وهذه إشارات وتلويحات
في بدائعها، وإنما ينجلي الغرض منها ويَبين، إذا تُكُلِّم على هذه التفاصيل،
وأُفرِدَ كُلُّ فن بالتمثيل، وسترى ذلك إن شاء اللّه، وإليه الرغبة في أن تُوفَّق
للبلوغ إليه والتُوَفُّر عليه، وإذ قد عرَّفتكُ أن لها هذا المجال الفسيحَ،
والشَّأوَ البعيد، فإني أضَعُ لك فصلاً، بعد فَصلٍ، وأجتهد بقدر الطاقة في الكَشف
والبحث.وهذا فصلٌ قسَّمْتُها فيه
قسمة عامية ومعنى العامية، أنك لا تجد في هذه الاستعارة قسمةً إلا أخصَّ من هذه
القسمة، وأنها قسيمةُ الاستعارة من حيث المعقول المتعارف في طبقات الناس وأصناف
اللغات، وما تجدُ وتسمعُ أبداً نظيرَه من عوامِّ الناس كما تسمع من خواصهم،
اعلم أن كل لفظة دخلتها
الاستعارة المفيدة، فإنها لا تخلو من أن تكونَ اسماً أو فعلاً، فإذا كانت اسماً
فإنه يقع مستعاراً على قسمين "أحدهما" أن تنقلَه عن مسمَّاه الأصلي إلى شيء آخر
ثابتٍ معلومٍ فتُجريَه عليه، وتجعلَه متناولاً له تناوُلَ الصفةِ مثلاً للموصوف،
وذلك قولك رأيت أسداً وأنت تعني رجلاً شجاعا و عَنَّت لنا ظَبية وأنت تعني امرأة و
أبديتُ نوراً وأنت تعني هُدًى وبياناً وحُجّةً وما شاكل ذلك، فالاسم في هذا كله كما
تراه متناولٌ شيئاً معلوماً يمكن أن يُنصَّ عليه فيقالَ: إنه عُنِيَ بالاسم وكُنِيَ
به عنه ونُقل عن مسمَّاه الأصلي فجُعل اسماً له على سبيل الإعارة والمبالغة في
التشبيه، والثاني: أن يؤخذ الاسم على حقيقته، ويُوضَع موضعاً لا يبينُ فيه شيء
يشارُ إليه فيقالَ: هذا هو المراد بالاسم والذي استعير له، وجُعل خليفةً لاسمه
الأصلي ونائباً مَنَابه، ومثالهُ قول لبيد: وغدَاةَ ريحٍ قد
كَشَفْتُ وقِـرَّةٍ إذ أصبحَتْ
بيَدِ الشَّمالِ زِمَامها
ومعلوم أنه ليس هناك مُشار إليه يمكن أن تُجْرَى اليد عليه، كإجراء الأسد و السيف
على الرجل في قولك انْبَرَى لي أسدٌ يَزْئِرُ و سللتُ سيفاً على العدوّ لا يُفَلُّ،
و الظباء على النساء في قوله "الظباء الغِيدِ" و النور على الهُدَى والبيان في قولك
أبديتُ نوراً ساطعاً وكإجراء اليد نفسها على من يعزُّ مكانه كقولك أتنازعني في يدٍ
بها أبطِشُ، وعين بها أبصرُ تريد إنساناً له حُكْم اليد وفعلها، وغناؤها ودَفْعُها،
وخاصّةُ العين وفائدتُها، وعزّة موقعها، ولطف موضعها لأنّ معك في هذا كله ذاتاً
يُنَصُّ عليها، تَرَى مكانَها في النفس، إذَا لم تجد ذكرها في اللفظ، وليس لك شيءٌ
من ذلك في بيت لبيد، بل ليس أكثر من أن تُخَيّل إلى نفسك أن الشَّمال في تصريف
الغَداة على حكم طبيعتها، كالمدبّر المصرِّفِ لما زمامُه بيده، ومَقادتُهُ في كفّه،
وذلك كلُّه لا يتعدَّى التخيُّلُ والوَهْم والتقدير في النفس، من غير أن يكون هناك
شيء يُحَسُّ، وذاتٌ تتحصَّل، ولا سبيل لك أن تقول: كَنَى باليد عن كذا، وأراد باليد
هذا الشيء، أو جَعَل الشيءَ الفُلاَنيَّ يداً كما تقول: كَنَى بالأسد عن زيد،
وعَنَى به زَيداً، وجعل زيداً أسداً، وإنما غايتُك التي لا مُطَّلعَ وراءها أن
تقول: أراد أن يُثبت للشمال في الغداة تصرُّفاً كتصرُّف الإنسان في الشيء يقلّبهُ،
فاستعار لها اليد حتى يبالغ في تحقيق الشبَهِ، وحُكْمُ الزمام في استعاراته للغداة
حكم اليد في استعارتها للشمال، إذ ليس هناك مشارٌ إليه يكون الزمامُ كنايةً عنه،
ولكنه وفَّى المبالغةَ شَرْطها من الطرفين، فجعل على الغداة زماماً، ليكون أتمَّ في
إثباتها مصرَّفةً، كاجعل للشمال يداً، ليكون أبلغ في تصييرها مُصَرِّفة، ويفصل بين
القسمين أنك إذا رجعت في القسم الأول إلى التشبيه الذي هو المغزَى من كل استعارة
تُفيد، وجدتَه يأتيك عفواً، كقولك في رأيت أسداً رأيت رجلاً كالأسد أو رأيت مثل
الأسد أو شبيهاً بالأسد وإن رُمْتَهُ في القسم الثاني وجدته لا يؤاتيك تلك
المؤاتاة، إذ لا وجه لأن تقول: إذا أصبح شيء مثل اليد للشمال أو حصل شبيه باليد
للشَّمال، وإنما يتراءى لك التشبيه بعد أن تَخْرِق إليه ستراً، وتُعمل تأمّلاً
وفكرْاً، وبعد أن تُغيِّر الطريقةَ، وتخرج على الحذْوِ الأول، كقولك: إذ أصبحت
الشَّمال ولها في قوة تأثيرها في الغداة شَبَهُ المالكِ تصريف الشيء بيده، وإجراءَه
على موافقته، وجَذْبَه نحو الجهة التي تقتضيها طبيعته، وتنحوها إرادته، فأنت كما
ترى تجدُ الشَّبه المنتَزع ها هنا إذا رجعتَ إلى الحقيقة، ووضعت الاسم المستعارَ في
موضعه الأصلي لا يلقاكَ من المستعار نَفْسه، بل مما يضاف إليه، ألا ترى أنك لم
تُرِدْ أن تجعلَ الشَّمال كاليد ومشبهةً باليد، كما جعلت الرجلَ كالأسد ومشبَّهاً
بالأسد، ولكنك أردت أن تجعل الشمال كذي اليد من الأحياء، فأنت تجعل في هذا الضرب
المستعارَ له وهو نحو الشمال ذا شيءٍ، وغرضُك أن تُثبت له حكم من يكون له ذلك الشيء
في فعل أو غيره، لا نفسَ ذلك الشيء فاعرفه. وهكذا قول زهير: "وَعُرّيَ أفْراسُ
الصّبا ورَوَاحِلُه" لا تستطيع أن تُثبت ذواتاً أو
شِبهَ الذوات تتناولُها الأفراسُ والرَّواحل في البيت، على حدّ تناوُل الأسدِ
الرجلَ الموصوفَ بالشجاعة، والبدرِ الموصوفَ بالحسن أو البهاء، والسحاب المذكورَ
بالسخاء والسماحة، والنورِ العلمَ، والهُدَى والبيان، وليس إلاّ أنك أردت أن
الصِّبا قد تُرك وأهمل، وفُقِد نِزاعُ النفس إليه وبَطَل، فصار كالأمر يُنْصَرفُ
عنه فتُعطَّل آلاته، وتُطرح أداته كالجهة من جهات المسير نحو الحج أو الغزو أو
التجارة يُقضى منها الوطَرُ، فتُحَطُّ عن الخيل التي كانت تُركب إليها لبُودُها،
وتُلقَى عن الإبل التي كانت تُحمَّل لها قتودُها، وقد يجيء وإن كان كالتكلّف أن
تقول إن الأفراس عبارة عن دواعي النفوس وشهواتها، وقواها في لذَّاتها، أو الأسبَابِ
التي تَفْتِل في حَبْل الصِبا، وتنصر جانبَ الهوى، وتُلهِب أريحيّة النشاط، وتُحرّك
مَرَح الشَّباب، كما قال "ونعم مَطيّةُ الجهلِ الشبابُ" وقال "كان الشبابُ مَطِيّةَ
الجَهْل" وليس من حقّك أن تتكلّف هذا في كل موضع، فإنه ربّما خرجَ بك إلى ما يضُرُّ
المعنى وينْبو عنه طَبْعُ الشعر، وقد يتعاطاه من يخالطه شيء من طباع التعمُّق،
فتجدُ ما يُفسد أكثر مما يُصلح، ولو أنك تطلبت للمطية في بيت الفرزدق:
لَعَمْرِي لئن
قَيّدْتُ نفسي لطـالـمـا سَعَيْتُ
وأوضعتُ المَطّيةَ في الجهلِ
عن الصواب، وعدلت عما يسبق إلى القلب، وذلك أن المعنى على قولك: لطالما سعيتُ في
الباطل، وقديماً كنت في الإسراع إلى الجهل بصُورة من يُوضع المطيّة في سفره، وسِرُّ
هذا الموضع يتجلَّى تمامَ التجلِّي إذا تُكُلِّم على الفَرْق بين التشبيه والتمثيل،
وسيأتيك ذلك إن شاء اللّه تعالى، وكذا قولهم: هو مُرْخَى العِنان، ومُلْقَى
الزِّمام، لا وجهَ لأن تروم شيئاً تُجري العِنان عليه ويتناوله، بل المعنى على
انتزاع الشبه من الفرس في حال ما يُرْخَى عِنانُه، وأن يُنظَر إلى الصورة التي
تُوجَد من حاله تلك في العقل، ثم يُجاء بها فيُعَارُها الرجُل، ويُتصوَّر بمقتضاها
في النفس ويُتمثّل، ولو قلت: إن العنان ها هنا بمعنى النهي، وأن المراد أن النهي قد
أُبعد عنه ونحو ذلك، دخلت في ظاهرٍ من التكلُّف، وأتعبت نفسك في غير جدوَى، وعادت
زيادتك نقصاناً، وطَلبُك الإحسانَ إساءة. واعلم أن إغفال هذا الأصل الذي عرّفتك من
أن الاستعارة تكون على هذا الوجه الثاني كما تكون على الأوّل مما يعدو إلى مثل هذا
التعمّق، فإنه نفسَهُ قد يصير سبباً إلى أن يقع قوم في التشبيه، وذلك أنهم إذا
وضعوا في أنفسهم أن كل اسم يستعار فلا بد من أن يكون هناك شيء يمكن الإشارة إليه
يتناوله في حال المجاز، كا يتناول مسمّاه في حال الحقيقة، ثم نظروا في نحو قوله
تعالى: "وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي" "طه:93" و"وأصْنَع الفُلْكَ بِأَعْيُنِنا"
"هود:73"، فلما لم يجدوا للفظة العين ما يتناوله على حدًّ تناول النُّور مثلاً
للهدى والبيان ارتبكوا في الشكّ وحاموا حول الظاهر، وحملوا أنفسهم على لزومه، حتى
يُفضي بهم إلى الضلال البعيد، وارتكاب ما يقدح في التوحيد، ونعوذ باللّه من
الخذلان. وطريقة أخرى، في بيان الفرق بين القسمين، وهو أن الشبَهَ في القسم الأول
الذي هو نحو رأيت أسداً - تريد رجلاً شجاعاً - وَصفٌ موجودٌ في الشيء الذي استعرت
اسمه وهو الأسد، وأما قولك إذا أصبحت بيد الشمال زمامها فالشبه الذي له استعرتَ
اليد، ليس بوصفٍ في اليد، ولكنه صفته تُكسبها اليدُ صاحبَها، وتَحصُلُ له بها، وهي
التصرف على وجه مخصوص وكذا قولك أفراس الصِّبا، ليس الشبه الذي له استعرت الأفراس
موجوداً في الأفراس، بل هو شبه يحصل لما يضاف إليه الأفراس، حيث يراد الحقيقة نحو
قولنا "عُرّي أفراس الغزو، و أجِمَّت خيل الجهاد"، وذلك ما يوجبه الفعل الواقع على
الأفراس، نحو أنّ وقوع الفعل الذي هو عُرّيَ على أفراس الغزو، يوجب الإمساك عن
الغزو والترك له وعلى هذا القياس. وإذ قد تقرر أمر الاسم في كون استعارته على هذين
القسمين، فمن حقّنا أن ننظر في الفعل هل يحتمل هذا الانقسام، والذي يجب العملُ عليه
أن الفعل لا يُتصوَّر فيه أن يتناول ذات شيء، كما يتصور في الاسم، ولكن شأن الفعل
أن يُثبت المعنى الذي اشتُقَّ منه للشيء في الزمان الذي تدل صيغته عليه، فإذا قلت:
ضرَبَ زيدٌ، أثبتَّ الضرب لزيد في زمان ماضٍ، وإذا كان كذلك، فإذا استعير الفعل لما
ليس له في الأصل، فإنه يُثبتُ باستعارته له وصفاً هو شبيه بالمعنى الذي ذلك الفعل
مشتق منه. بيان ذلك أن تقول: نطقَت الحال بكذا، و أخبرتني أساريرُ وجهه بما في
ضميره، وكلّمتني عيناه بما يحوي قلبه، فتجد الحال وصفاً هو شبيه بالنطق من الإنسان،
وذلك أن الحال تدلّ على الأمر ويكون فيها أَمَاراتٌ يعرف بها الشيء، كما أن النطق
كذلك، وكذلك العين فيها وصف شبيه بالكلام، وهو دلالتها بالعلامات التي تظهرُ فيها
وفي نظرها وخواصّ أوصافٍ يُحْدَس بها على ما في القلوب من الإنكار والقبول، ألا ترى
إلى حديث الجمحي? حُكِي عن بعضهم أنه قال: أتيتُ الجمحي أستشيره في امرأة أردت
التزوج بها فقال: أقصيرة هي أم غير قصيرة? قال: فلم أفهم ذلك، فقال لي: كأنك لم
تفهم ما قلتُ، إنّي لأعرف في عين الرَّجل إذا عرف، وأعرفُ فيها إذا أنكر، وأعرفُ
إذا لم يعرف ولم ينكر، أمَّا إذا عرف، فإنها تخَاوَصُ، وإذا لم يعرف ولم ينكر فإنها
تَسْجُو، وإذا أنكر فإنها تجحظُ، أردت بقولي قصيرة، أي هي قصيرة النسب تُعَرف
بأبيها أو جَدّها. قال الشيخ أبو الحسن: وهذا من قول النسّابة البكري لرؤبة بن
العجاج لما أتاه فقال له من أنت? قال رؤبة بن العجاج فقال قَصُرتَ وعُرِفتَ. قال:
وعلى هذا المعنى قول رؤبة:ؤبة: قد رَفَعَ
العجَّاج ذكري فادعُنِي باسْمٍ إذا
الأنساب طالت يَكْفِنِي
فيه إلى دليل، ولكن إذا جرى الشيء في الكلام هو دعوى في الجملة، كان الآنس للقارئ
أن يقترن به ما هو شاهد فيه، فلم يُرَ شيءٌ أحسنَ من إيصال دعوى ببرهان. وإذا كان
أمرُ الفعل في الاستعارة على هذه الجملة، رجَع بنا التحقيق إلى أنّ وصف الفعل بأنه
مستعارٌ، حكمٌ يرجع إلى مَصْدره الذي اشتُقّ منه، فإذا قلنا في قولهم: نطقت الحال،
أن نَطَقَ مستعار، فالحكم بمعنى أن النُّطق مستعار، وإذا كانت الاستعارة تنصرف إلى
المصدر كان الكلام فيه على ما مضى، ومما تجب مراعاته أن الفعل يكون استعارة مرّةً
من جهة فاعله الذي رُفع به، ومثاله ما مضى ويكون أُخرى استعارةً من جهة مفعوله،
وذلك نحو قول ابن المعتزّ: جُمعَ الحقُّ
لنا فـي إمـامٍ قَتَلَ البُخْلَ
وأحيى السَّمَاحَا
مستعارينَ بأن عُدّيا إلى البخل والسماح، ولو قال: قتل الأعداء وأحيى، لم يكن
قَتَلَ استعارةً بوجه، ولم يكن أحيى استعارة على هذا الوجه وكذا قوله:
وأَقْرِي
الهمومَ الطارقاتِ حَزامةً
جميعاً، فأما من جهة الفاعل فهو محتمل للحقيقة، وذلك أن تقول: أقري الأضياف
النازلين اللحمَ العبيطَ ومثله قوله: "قَرَى الهمَّ إذْ ضافَ الزَّماعَ" وقد يكون
الذي يعطيه حكمَ الاستعارة أحدُ المفعولين دون الآخر كقوله: نقريهمُ
لَهْذَمِيَّاتٍ نَقُـدُّ بـهـا مَا كَانَ خَاطَ
عليهم كُلُّ زَرَّادِ | |
|
ebrehim
مدير

عدد المساهمات : 2239
تاريخ التسجيل : 19/10/2011
 |  موضوع: الاستعاره المفيده موضوع: الاستعاره المفيده  الثلاثاء 12 يونيو 2012, 18:01 الثلاثاء 12 يونيو 2012, 18:01 | |
| اعلم أن الاستعارة كما علمت
تعتمد التشبيهَ أبداً، وقد قلت: إنّ طُرُقه تختلف، ووعدتُك الكلام فيه، وهذا الفصل
يعطي بعضَ القول في ذلك بإذن اللّه تعالى، وأنا أريد أن أُدرِّجها من الضَّعف إلى
القوة، وأبدأ في تنزيلها بالأدنى، ثم بما يزيد في الارتفاع، لأن التقسيم إذا أُريغَ
في خارج من الأصل، فالواجب أن يُبدَأ بما كان أقلَّ خروجاً منه، وأدنى مدًى في
مفارقته، وإذا كان الأمر كذلك، فالذي يستحِقُّ بحكم هذه الجملة أن يكون أوّلاً من
ضروب الاستعارة، أن يُرَى معنى الكلمة المستعارة موجوداً في المستعار له من حيث
عموم جنسه على الحقيقة، إلا أنّ لذلك الجنس خصائص ومراتبَ في الفضيلة والنقص
والقوّة والضعف، فأنت تستعير لفظ الأفضل لما هو دونه، ومثاله استعارةُ الطيران لغير
ذي الجناح، إذا أردت السرعة، و انقضاض الكواكب للفرس إذا أسرع في حركته من علوّ، و
السباحة له إذا عدَا عدواً كان حاله فيه شبيهاً بحالة السابح في الماء، ومعلومٌ أن
الطيران والانقضاضَ والسباحةَ والعدوَ كلها جنس واحد من حيث الحركة على الإطلاق،
إلا أنهم نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتها، فأفردوا حركةَ كل نوع منها باسم، ثم
إنهم إذا وجدوا في الشيء في بعض الأحوال شبهاً من حركةِ غير جنسه، استعاروا له
العبارة من ذلك الجنس، فقالوا في غير ذي الجناح طار كقوله:
وطِرْتُ بِمُنْصُلي في يَعْمَلاتٍ
سمع هَيْعَةً طار إليها، وكما قال: لَوْ يَشَا طَارَ بـهِ ذُو مَـيْعةٍ لاَحِقُ الآطال
نَهْدٌ ذو خُصَلْ
الماء على وجه مخصوص، وذلك أن يفارق مكانهُ دَفْعَةً فينبسط، ثم إنه استعير للفجر،
كقوله: كالفَجْرِ فَاضَ على نُجُوم الغَيْهبِ
شبيهة بانبساط الماء وحركته في فَيْضِهِ، فأما استعارة فاض بمعنى الجُود، فنوع آخر
غير ما هو المقصود ها هنا، لأن ألقصد الآن إلى المستعار الذي تُوجد حقيقة معناه من
حيث الجنس في المستعار له، وكذلك قول أبي تمام: وقَدَ نَثَرَتْهُمْ رَوْعَةٌ ثُمّ أَحْدَقُواْبِهِ مِثْلَمَا
أَلَّفَتْ عِقْدَاً مُنْظَّمَا
نَثَرَتْهُمْ فَـوقَ الأُحْـيَدِبِ نَـثْـرَةً كما نُثِرَتْ
فوق العَرُوسِ الدَّراهِمُ
للأجسام الصغار، كالدراهم والدنانير والجواهر والحبوب ونحوها، لأن لها هيئةً
مخصوصةً في التفرق لا تَأْتِي في الأجسام الكبار، ولأن القصد بالنثر أن تُجمَعُ
أشياء في كفّ أو وِعاء، ثم يقع فعلٌ تتفرّق معه دَفْعَةً واحدةً، والأجسام الكبار
لا يكون فيها ذلك، لكنه لمّا اتَّفق في الحرب تساقُطُ المنهزمين على غيرترتيب
ونظام، كما يكون في الشيء المنثور، عبَّر عنه بالنثر، ونسب ذلك الفعل إلى الممدوح،
إذْ كان هو سبب ذلك الانتثار، فالتفرُّق الذي هو حقيقة النثر من حيث جنس المعنى
وعمومِه، موجودُ في المستعار له بلا شبهة، ويبيّنه أن النَّظم في الأصل لجمع
الجواهر وما كان مثلها في السلوك، ثم لمّا حصل في الشَّخْصَين من الرجال أن يجمعهما
الحاذِق المبدعُ في الطعن في رُمْحٍ واحد ذلك الضربَ من الجمع، عبَّر عنه بالنَّظم،
كقولهم: انتظمها برمحه، وكقوله: قالوا وينظمُ فَارِسَيْن بطَعْنَةٍ
اللفظة وقعت في الأصل لما يُجْمع في السُّلوك من الحبوب والأجسام الصغار، إذ كانت
تلك الهيئة في الجمع تَخُصُّها في الغالب، وكان حصولها في أشخاص الرجال من النادر
الذي لا يكاد يقع، وإلا فلو فرضنا أن يكثرَ وجودُه في الأشخاص الكبيرة، لكان لفظ
النظم أصلاً وحقيقة فيها، كما يكون حقيقةً في نحو الحبوب، وهذا النحو لشدة الشَّبه
فيه، يكاد يلحقُ بالحَقيقة، ومن هذا الحدِّ قوله: وفي يَدِكَ السَّيْف الَّذِي امتنعَتْ به صَفَاةُ الهُدَى
من أَنْ تَرِقَّ فتُخْرَقَا
في الثوب، وهو في الصفاة استعارة، لأنه لمّا قال تَرِقَّ، قربت حالها من حالِ
الثوب، وعلى ذلك فإنَّا نعلم أن الشق والصدع حقيقة في الصَّفاة، ونعلم أن الخرق
يجامعهما في الجنس، لأن الكلَّ تفريقٌ وقطعٌ، ولو لم يكن الخرق والشق واحداً، لما
قلت: شققتُ الثوبَ، والشَّق عيبٌ في الثوب، و تَشَقََّقَ الثوبُ قول من لا يستعير،
ولكن لو قلتَ "خرق الحِشمة"، لم يكن من الحقيقة في شيء، وكان خارجاً من هذا الفن
الذي نحن فيه، لأنه ليس هناك شق، ولو جاءَ شَقَّ الحِشمة أو صَدَعَ مثلاً، كان كذلك
أعني لا يكون له أصلٌ في الحقيقة ولا شَبهٌ بها. ومن هذا الضرب قوله تعالى:
"وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ" "سبأ:91" يُعَدُّ استعارةٌ من حيث إن التمزيق
للثوب في أصل اللغة، إلا أنه على ذاك راجع إلى الحقيقة، من حيث إنه تفريق على كل
حال، وليس بجنس غيره، إلاّ أنهم خصّوا ما كان مثل الثوب بالتمزيق، كما خصُّوه
بالخرق، وإلا فأنت تعلم أن تمزيق الثوب تفريقُ بعضه من بعض، ومثله أن القطع إذا
أطلق، فهو لإزالة الاتصال من الأجسام التي تلتزق أجزاؤها، وإذا جاء في تفريق
الجماعة وإبعاد بعضه عن بعض، كقوله تعالى: "وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَماً"
"الأعراف:861"، كان شِبْهَ الاستعارة، وإن كان المعنى في الموضعين على إزالة
الاجتماع ونَفْيهِ. فإن قلت: قطع عليه كلامَهُ، أو قلت: نَقْطَع الوقت بكذا، كان
نوعاً آخر، ومن الاستعارة القريبة في الحقيقة قولهم: أَثْرَى فلانٌ من المجد، وَ
أفلس من المروءة، وكقوله: إنْ كانَ أغْنَاها السلُوُّ، فإنَّنـي أَمْسَيْتُ من
كَبِدِي ومِنْهَا مُعْدِمَا
الشيء، كثرته عندك، ووصفُ الرجل بأنه كثير المجْد أو قليل المروءَة، كوصفه بأنه
كثير العلم أو قليل المعرفة، في كونه حقيقة، وكذلك إذا قلت: أَثْرَى من الشوق أو
الحُزْن كما قال: قَدْ وَقَفْنَا على الدِّيارِ وفي الرَّكْ بِ خَرِيبٌ من
الغَرامِ ومُثْرِي
وحزنُه وغرامُه، وإذا كان كذلك، فهو في أنه نُقل إلى شيء جِنْسُه جِنْسُ الذي هو
حقيقةٌ فيه، بمنزلة طار، أو أظهرُ أمراً منه، وكذا معنى أعدَم من المال، أنه خلا
منه، وأن المال يزول عنه فإذا أخبر أن كَبِدَه قد ذهبت عنه، فهو في حقيقةِ مَنْ ذهب
ماله وعدِمَه، والعُدْم في المال وفي غير المال بمنزلة واحدة لا تتغيَّر له فائدة،
و المُعْدَم موضوع لمن عَدِم ما يحتاج إليه، فالكبد مما يحتاج إليه، وكذلك
المحبوبة، فإنما تقع هذه العبارة في نفسك موقع الغريب من حيث أن العُرف جَرَى في
الإعدام بأن يُطلَق على من عَدِم ما جنسُهُ جنسُ المال، ويؤنّسك بما قلتُ، أنك لو
قلت: عدم كبدَه، لم يكن مجازاً، ولم تجد بينه وبين خلا من كبده وزالت عنه كبده
كبيرَ فَرْقٍ، ألا تراك تقول: الفَرَسُ عَادِمٌ للطِّحَال تريد: ليس له طحال، وهذا
كلام لا استعارة فيه، كما أنك لو قلت: الطحال معدوم في الفرس كان كذلك، ومن اللائق
بهذا الباب البَيِّن أمرُه، ما أنشده أبو العباس في الكامل من قول الشاعر:
لم تَلقَ قَوْمَاً همُُ شَرٌّ لإخْوَتِهِمْ مِنَّا
عَشِيَّةَ يَجْرِي بالدَّمِ الوادي
تَقْريِهِمُ لَهْذَمِيَّاتٍ نَقُـدُّ بـهـا ما كَانَ خاط
عَلَيْهِم كُلُّ زَرَّادِ
خِرَقَ القميص والسَّرْدُ يضُمُّ حَلَقَ الدِرْع، أفلا تراهُ بَيَّنَ أن جنسهما
واحدٌ، وأن كلاًّ منهما ضَمٌّ ووَصْلٌ وإنما يَقَعُ الفرقُ من حيث أن الخياطة ضَمُّ
أطراف الخِرقَ بِخَيْطِ يُسْلَك فيها على الوجه المعلوم، و الزَّرْدُ ضّم حَلَق
الدرع بمداخلةٍ توجد بينها، إلاّ أن الشِّكال الذي يُلزِم أحدَ طرفَي الحَلْقةِ
الآخرَ بدخوله في ثُقبتيهما، في صورة الخيط الذي يذهب في منافذ الإبرة، واستقصاءُ
القول في هذا الضرب، والبحث عن أسراره، لا يمكن إلا بعد أن تُقَرَّر الضروب
المخالفةُ له من الاستعارة، فأقْتصر منه على القدرالمذكور، وأعود إلى القسمة، ضربٌ
ثانٍ يُشبه هذا الضرب الذي مضى، وإن لم يكن إياه، وذلك أن يكون الشبهُ مأخوذاً من
صِفةٍ هي موجودٌ في كل واحدٍ من المستعَار له والمُستعارِ منه على الحقيقة، وذلك
قولُك: رأيت شمساً، تريد إنساناً يتهلَّل وجهه كالشمس، فهذا له شَبَهٌ باستعارة
طارلغيرذي الجناح وذلك أن الشبه مُراعَى في التلألؤ، وهو كما تعلم موجودٌ في نفس
الإنسان المتهلل، لأنّ رَوْنقَ الوجه الحسن من حيث حسنُ البصر، مجانسٌ لضوء الأجسام
النيّرة، وكذلك إذا قلت: رأيت أسداً تريد رجلاً، فالوصف الجامعُ بينهما هو الشجاعة،
وهي على حقيقتها موجودة في الإنسان، وإنما يقع الفرقُ بينه وبين السَّبع الذي
استعرتَ اسمه له فيها، من جهةً القُوَّة والضعفِ والزيادة والنقصان، وربما ادُّعي
لبعض الكُماةِ والبُهَم مساواةُ الأسد في حقيقة الشجاعة التي عمود صورتها انتفاءُ
المخافة عن القلب حتى لا تخامرَه، وتُفرِّقَ خواطرَه وتُحَلِّلَ عزيمته في الإقدام
على الذي يباطشه ويريد قَهْرَه، وربما كفّ الشُّجاع عن الإقدام على العدوّ لا لخوف
يملك قلبه ويَسْلُبه قواه، ولكن كما يكُفُّ المنهيُّ عن الفعل، لا تخونه في تعاطيه
قوّةٌ، وذلك أن العاقل من حيث الشرع منهيٌّ عن أن يُهلك نفسه، أتَرَى أنّ البطلَ
الكميَّ إذا عَدِمَ سلاحاً يقاتل به، فلم ينهَض إلى العدوّ، كان فاقداً شجاعته
وبأسَه، ومتبرّئاً من النَّجْدةِ التي يُعْرَفُ بها، ثم إن الفرق بين هذا الضرب
وبين الأول أن الاشتراك ها هنا في صفة توجد في جنسين مختلفين، مثلُ أنّ جنس الإنسان
غير جنس الشمس، وكذلك جنسهُ غيرُ جنس الأسد، وليس كذلك الطيران و جريُ الفرس،
فإنهما جنس واحد بلا شبهة، وكلاهما مُرورٌ وقطعٌ للمسافة، وإنما يقع الاختلاف
بالسرعة، وحقيقة السرعة قلّة تخلُّلِ السكون للحركات، وذلك لا يوجب اختلافاً في
الجنس، فإن قلت: فإذَنْ لا فرق بين
استعارة طَار للفرس وبين استعارة الشَفَة للفرس، فهّلا عددتَ هذا في القسم
اللَّفْظِيّ غير المفيد? ثم إنك إن اعتذرت بأنّ في طار خصوصَ وصفٍ ليس في عَدَا و
جَرَى، فكذلك في الشفة خصوصُ وصفٍ ليس في الجحفلة، فالجواب إنِّي لم أعُدَّه في ذلك
القسم، لأجل أنّ خصوص الوصف الكائن في طَارَ مُرَاعًى في استعارته للفرس، ألا ترَاك
لا تقوله في كل حال، بل في حالٍ مخصوصة وكذا السباحة، لأنك لا تستعيرها للفرس في كل
أحوال حَرْبه، نعم، وتأبى أن تعطيَها كُلّ فرس، فالقَطُوف البليدُ لا يوصف بأنه
سابح، وأما استعارة اسمٍ لعضو نحو
الشفة والأنف فلم يُراعَ فيه خصوص الوصف، ألا ترى أن العجّاج لم يرد بقوله
"ومَرْسِنَاً مُسرَّجَاً"، أن يشبّه أنف المرأة بأنف نوع من الحيوان، لأن هذا العضو
من غير الإنسان لا يوصف بالحسن، كما يكون ذلك في العين والجيد، وهكذا استعارة
الفِرْسِن للشاة في قول عائشة رضي اللّه عنها: ولَوْ فِرْسِنَ شاةٍ، وهو للبعير في
الأصل ليس لأن يشبَّه هذا العضو من الشاة به من البعير، كيف ولا شَبَه هناك، وليس
إذَنْ في مجيءُ الفِرْسِن بَدَل الظِلْف أمرٌ أكثر من العضو نفسه، ضرب ثالثٌ، وهو
الصَّميم الخالص من الاستعارة، وحدُّه أن يكون الشبَهُ مأخوذاً من الصُّور العقلية،
وذلك كاستعارة النُّور للبيان والحجة الكاشفة عن الحق، المزِيلة للشكّ النافية
للرَّيْب، كما جاء في التَّنزيل من نحو قوله عزّ وجلّ: "واتَّبَعُواْ النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ" "الأعراف:751" وكاستعارة الصراط للدِّين في قوله تعالى:
"اهْدِنَا الصِرَاطَ المُسْتَقِيمَ" "الفاتحة:5"، و "وَإنَّكَ لَتَهْدِي إلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ" "الشورى:25" فإنك لا تشُكُّ في أنه ليس بين النور والحجة ما
بين طيران الطائرو جرى الفرس من الاشتراك في عموم الجنس، لأن النور صفة من صفات
الأجسام محسوسةٌ، والحجة كلامٌ وكذا ليس بينهما ما بين الرجل والأسد من الاشتراك في
طبيعةٍ معلومةٍ تكون في الحيوان كالشجاعة، فليس الشبه الحاصل من النور في البيان
والحجة ونحوهما، إلاّ أنّ القلب إذا وردت عليه الحجَّة صار في حالة شبيهة بحال
البصر إذا صادف النور، ووُجِّهت طلائعُه نحوه، وجال في مَصَارفه وانتشر، وانبَتَّ
في المسافة التي يسافر طَرْفُ الإنسان فيها، وهذا كما تعلم شَبهٌ لستَ تحصل منه على
جنس ولا على طبيعة وغريزة، ولا على هيئة وصورة تدخل في الخِلقة، وإنما هو صورة
عقلية. واعلم أن هذا الضرب هو المنزلةُ التي تبلغ عِندها الاستعارة غاية شرفها،
ويتسع لها كيف شاءت المجال في تفنُّنها وتصرُّفها، وها هنا تَخْلُص لطيفةً روحانية،
فلا يبصرها إلا ذوو الأذهان الصافية، والعقول النافذة، والطباع السليمة، والنفوس
المستعدَّة لأن تَعِيَ الحكمةَ، وتعرف فَصْل الخطاب، ولَهَا ها هنا أساليبُ كثيرة،
ومسالك دقيقة مختلفةٌ، والقول الذي يجري مَجْرَى القانون والقسمةِ يغمضُ فيها، إلا
أنّ ما يجب أن تعلم في معنى التقسيم لها أنها على أصول أحدها: أن يؤخذ الشَّبه من
الأشياء المشاهدة والمدركة بالحواسّ على الجملة للمعاني المعقولة، والثاني: أن يؤخذ
الشبه من الأشياء المحسوسة لمثلها، إلا أن الشّبه مع ذلك عقليٌّ، والأصل الثالث: أن
يؤخذ الشَّبه من المعقول للمعقول، فمثال ما جرى على "الأصل الأول" ما ذكرتُ لك من
استعارة النور للبيان والحجّة، فهذا شَبَهٌ أُخِذ من محسوس لمعقول، ألا ترى أن
النور مشاهَدٌ محسوس بالبصر، والبيانُ والحجّةُ مما يؤدّيه إليك العقل من غير واسطة
من العين أو غيرها من الحواس، وذلك أن الشَّبه ينصرف إلى المفهوم من الحروف
والأصوات، ومدلولُ الألفاظ هو الذي ينوِّر القلب لا الألفاظ، هذا و النور يستعار
للعلم نفسه أيضاً والإيمان، وكذلك حكم الظلمة، إذا استعيرت للشُّبهة والجهل والكفر،
لأنه لا شُبْهةَ في أن الشَّبهَ والشكوك من المعقول، ووجه التشبيه أن القلب يحصُل
بالشبهة والجهلِ، في صفة البصر إذا قَيّده دُجَى الليل فلم يجدْ منصرَفاً وإن
استعيرت للضلالة والكفر، فلأنّ صاحبهما كمن يسعى في الظلمة فيذهَب في غير الطريق،
وربما دُفِع إلى هُلْك وتردَّى في أُهْوِيَّة، ومن ذلك استعارة القِسْطاس للعدل
ونحو ذلك من المعاني المعقولة التي تُعْطَى غيرَها صِفةَ الاستقامة والسَّداد، كما
استعاره الجاحظ في فصلٍ يذكر فيه علم الكلام، فقال: هو العِيار على كل صِنَاعة،
والزِّمام على كل عبارة، والقِسْطاسُ الذي به يُسْتَبان كل شيء ورُجْحَانه والراووق
الذي به ىُعْرْف صفاء كل شيء وكَدَره، وهكذا إذا قيل في النَّحو: إنه ميزان الكلام
ومِعْياره، فهو أخذُ شبهٍ من شيء هو جسمٌ يُحَسُّ ويشاهَد، لمعنًى يُعْلَم ويُعْقَل
ولا يدخل في الحاسّة، وذلك أظهر وأبين من أن يُحتاج فيه إلى فضل بيان، وأما تفنُّنه
وسَعته وتصرُّفه من مَرْضِيٍّ ومسخوطٍ، ومقبول ومرذُول، فحقُّ الكلام فيه بعدَ أن
يقع الفراغُ من تقرير الأصول، ومثال "الأصل الثاني"، وهو أخذ الشَّبه من المحسوس
للمحسوس، ثم الشبهُ عَقليٌّ، قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إياكم وخَضْراء
الدِمَن"، الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لا يخفى وكلاهما جسمٌ، إلا أنه لم
يُقصَد بالتشبيه لونُ النبات وخُضرته، ولا طعمه ولا رائحته، ولا شكله وصورته ولا ما
شاكل ذلك ولا ما يسمَّى طبعاً كالحرارة والبرودة المنسوبتين في العادة إلى العقاقير
وغيرها مما يُسَخَّن بدن الحيوان ويَبْرُدُ بحصوله فيها، ولا شيءٌ من هذا الباب بل
القصدُ شَبَهٌ عقليٌّ بين المرأة الحسناءِ في المنبت السوء، وبين تلك النابتة على
الدِِّمنة، وهو حُسْنُ الظاهر في رأى العين مع فساد الباطن، وطيبُ الفَرع مع خبث
الأصل، وكما أنهم إذا قالوا: هو عَسَلٌ إذا ياسرتَه، وإن عاسَرتَه فهو صَاب، كما
قال:قرير الأصول، ومثال "الأصل الثاني"، وهو أخذ الشَّبه من المحسوس للمحسوس، ثم
الشبهُ عَقليٌّ، قولُ النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إياكم وخَضْراء الدِمَن"، الشبه
مأخوذ للمرأة من النبات كما لا يخفى وكلاهما جسمٌ، إلا أنه لم يُقصَد بالتشبيه لونُ
النبات وخُضرته، ولا طعمه ولا رائحته، ولا شكله وصورته ولا ما شاكل ذلك ولا ما
يسمَّى طبعاً كالحرارة والبرودة المنسوبتين في العادة إلى العقاقير وغيرها مما
يُسَخَّن بدن الحيوان ويَبْرُدُ بحصوله فيها، ولا شيءٌ من هذا الباب بل القصدُ
شَبَهٌ عقليٌّ بين المرأة الحسناءِ في المنبت السوء، وبين تلك النابتة على
الدِِّمنة، وهو حُسْنُ الظاهر في رأى العين مع فساد الباطن، وطيبُ الفَرع مع خبث
الأصل، وكما أنهم إذا قالوا: هو عَسَلٌ إذا ياسرتَه، وإن عاسَرتَه فهو صَاب، كما
قال: عَسَلُ الأخلاقِ ما يَاسرتَهُ فإذا عَاسرتَ
ذُقْتَ السَّلَعا
الغرض الحلاوةَ والمرارةَ اللتين تصفهما لك المَذاقة ويُحسُّهما الفم واللسان،
وإنما المعنى أنك تجد منه في حالة الرِّضى والموافقة ما يملَؤُك سروراً وبهجةً، حسب
ما يجد ذائق العسل من لذَّة الحلاوة ويهجمُ عليك في حالة السُّخط والإباء ما يشدِّد
كراهتَكَ ويَكْسِبك كَرْباً، ويجعلك في حال من يذوق المُرَّ الشديد المرارة، وهذا
أظهر من أن يخفى، ومن هذا الأصل استعارة الشمس للرجل تصفُه بالنباهة والرُّفعة
والشَّرف والشهرة وما شاكل ذلك من الأوصاف العقلية المحضة التي لا تلابسها إلاّ
بغريزة العقل، ولا تعقلها إلا بنظر القلب، ويظهر من هاهنا "أصل آخر" وهو أنّ اللفظة
الواحدة تستعار على طريقين مختلفين، ويُذْهَب بها في القياس والتشبيه مذهبين،
أحدهما يُفضِي إلى ما تناله العيون، والآخر يُومِئُ إلى ما تُمثِّله الظنون، ومثال
ذلك قولك: نجوم الهُدَى، تعني أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فإنه
استعارةٌ توجب شَبَهاً عقليّاً، لأن المعنى أنّ الخلق بعد رسول اللّه صلى الله عليه
وسلم اهتدوا بهم في الدين كما يهتدي السارون بالنجوم، وهذا الشبه باقٍ لهم إلى يوم
القيامة، فبالرجوع إلى علومهم وآثارِهم وفِعالهم وهَدْيهم تُنال النجاة من الضلالة،
ومن لم يطلب الهُدَى من جهتهم فقد حُرم الهدَى ووقع في الضلال، كما أنّ من لم ينظر
إلى النجوم في ظلام اللّيل ولم يتلقَّ عنها دلالتها على المسالك التي تُفضي إلى
العِمارة ومعادن السلامة وخالفَها، وقع في غير الطريق، وصار بَترْكِهِ الاهتداء بها
إلى الضلال البعيد، والهُلْك المُبيد، فالقياس على النجوم في هذا ليس على حدِّ
تشبيه المصابيح بالنجوم، أو النيران في الأماكن المتفرقة، لأن الشَّبَه هناك من حيث
الحسُ والمشاهدة، لأن القصد إلى نفس الضوء واللَّمعان، والشَّبه ها هنا من حيث
العَقْل، لأن القصد إلى مقتضَى ضَوْء النجوم وحُكْمه وعائدته، ثم ما فيها من
الدلالة على المنهاج، والأمن من الزيغ عنه والاعوجاج، والوصول بهذه الجُملة منها
إلى دار القرار ومحل الكرامة نسأل اللّه تعالى أن يرزقنا ذلك، ويُديم توفيقنا للزوم
ذلك الاهتداء، والتصرف في هذا الضياء، إنه عزّ وجلّ وليُّ ذلك والقادر عليه، ومما
لا يكون الشبه فيه إلا عقلياً، قولُنا في أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم
مِلْحُ الأنام، وهو مأخوذ من قوله عليه السلام: "مَثَلُ أصحابي كمثل الملح في
الطَّعام، لا يصْلح الطَّعام إلا بالملح"، قالوا: فكان الحسن رحمة اللّه عليه يقول:
فقد ذهب مِلْحُنا، فكيف نصنع?، فأنت تعلم أنْ لا وجه ها هنا للتشبيه إلا من طريق
الصُّورة العقلية، وهو أن الناس يصلُحُونَ بهم كما يصلُح الطعام بالملح، والشَّبهُ
بين صلاح العامّة بالخاصّة وبين صلاح الطعام بالملح، لا يُتصوَّر أن يكون محسوساً،
وينطوي هذا التشبيهُ على وجوب موالاةِ الصحابة رضي اللّه عنهم، وأن تُمْزَج
محبَّتُهم بالقلوب والأرواح، كما يُمزَج الملح بالطعام، فباتِّحاده به ومداخلته
لأجزائه يَطِيبُ طعمه، وتَذهب عنه وَخَامته، ويصير نافعاً مغذياً، كذلك بمحبّة
الصحابة رضي اللّه عنهم تصلح الاعتقادات، وتنتفى عنها الأوصاف المذمومة، وتطيب
وتغذو القلوب، وتُنَمَّى حياتُها، وتُحفَظ صحتها وسلامتها، وتَقيها الزَّيغَ
والضلالَ والشك والشبهة والحيرة، وما حُكْمُه في حال القلب من حيث العقل، حُكْمُ
الفساد الذي يعرض لمزاج البدن من أكل الطعام الذي لم يُصْلح بالملح، ولم تنتفِ عنه
المضار التي من شَأْنِ الملح أن يُزيلها، وعلى ذلك جاء في صفتهم أنّ: حُبَّهم إيمان
وبغضهم نفاقٍ، هذا ولا معنى لصلاح الرجل بالرجل إلاّ صلاح نِيَّتهُ واعتقاده،
ومحالٌ أن تصلُح نِيَّتك واعتقادك بصاحبك وأَنْتَ لا تراه مَعْدِن الخير
ومَعَانَهْ، وموضع الرُّشد ومكانه ومن علمتَه كذلك، مازَجَتْك محبّتُه لا محالة،
وسِيط وُدُّه بلحمك ودمك، وهل تحصل من المحبّة إلاّ على الطاعة والموافقة في
الإرادة والاعتقاد، قياسُه قِياس الممازجة بين الأجسام، ألا تراك تقول: فلانٌ قريبٌ
من قلبي، تريد الوِفاق والمحبَّة، وعلى هذه الطريقة جرى تمثيل النحو في قولهم:
النحو في الكلام، كالملح في الطعام، إذ المعنى أن الكلام لا يستقيمُ ولا تحصل
منافعه التي هي الدلالات على المقاصد، إلاّ بمراعاة أحكام النحو فيه، من الإعراب
والترتيب الخاصّ، كما لا يُجْدِي الطعامُ ولا تحصُلُ المنفعة المطلوبةُ منه، وهي
التغذية، ما لم يُصْلح بالملح، فأمَّا ما يتخيّلونه من أن معنى ذلك: أن القليلَ من
النحو يُغني، وأن الكثيرَ منه يُفسد الكلام كما يُفسد الملحُ الطعامَ إذا كثر فيه
تحريفٌ، وقولٌ بما لا يتحصَّل على البَحْث، وذلك أنه لا يُتَصَوّر الزيادةُ
والنقصانُ في جريان أحكام النحو في الكلام، ألا ترَى أنه إذا كان من حكمه في قولنا:
كان زيدٌ ذاهباً، أن يُرفَع الاسم ويُنصَب الخبر، لم يخلُ هذا الحكم من أن يوجد أو
لا يوجد، فإن وُجد فقد حصل النحوُ في الكلام، وعَدَلَ مِزاجَهُ به، ونُفِي عنه
الفسادُ، وأنْ يكون كالطعام الذي لا يَغْذُو البدن وإن لم يوجد فيه فَهُو فاسدٌ
كائن بمنزلة طعام لم يُصلح بالملح، فسامعه لا ينتفع به بل يستضرُّ، لوقوعه في عمياء
وهجوم الوحشة عليه، كما يوجبه الكلام الفاسد العاري من الفائدة، وليس بين هاتين
المنزلتين واسطةٌ يكون استعمالُ النحو فيها مذموماً وهكذا القول في كلِّ كلام، وذلك
أن إصلاح الكلامِ الأول بإجرائه عل حكم النحو، لا يُغْني عنه في الكلام الثاني
والثالث، حتى يُتوَّهم أن حصولَ النحوِ في جملة واحدة من قصيدة أو رسالة يُصلح سائر
الجمل، وحتى يكون إفراد كل جُملة بحكمها منه تكريراً له وتكثيراً لأجزائه، فيكون
مَثَلُهُ مَثَل زيادة أجزَاء الملح على قدر الكفاية. وكذلك لا يُتصور في قولنا: كان
زيد منطلقاً، أن يتكرَّرَ هذا الحكم ويتكثّر على هذا الكلام، فيصير النحو كذلك
موصوفاً بأن لَهُ كثيراً هو مذمومٌ، وأن المحمودَ منه القليلُ، وإنما وَزَانه في
الكلام وِزَانُ وقوف لسان الميزان حتى يُنبئ عن مساواة ما في إحدى الكفتين ما في
الأخرى، فكما لا يُتصور في تلك الصفة زيادةٌ ونقصان، حتى يكون كثيرُها مذموماً
وقليلها محموداً، كذلك الحكم في الصِّفة التي تحصل للكلام بإجرائه على حكم النحو
ووَزْنِهِ بميزان، فقول أبي بكر الخوارزمي: "والبُغْضُ عِنْدِي كثرةُ الإعراب"
كلامٌ لا يُحصَل منه على طائل، لأنّ الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة، إن اعتبرنا
الكلام الواحد والجملة الواحدة، وإن اعتبرنا الجُمُل الكثيرةَ وجعلنا إعراب هذه
الجملة مضموماً إلى إعراب تلك، فهي الكثرة التي لا بدّ منها، ولا صلاح مع تركها،
والخليقُ بالبُغْض مَنْ ذَمَّها وإن كان أراد نحو قول الفرزدق:حكام النحو فيه، من
الإعراب والترتيب الخاصّ، كما لا يُجْدِي الطعامُ ولا تحصُلُ المنفعة المطلوبةُ
منه، وهي التغذية، ما لم يُصْلح بالملح، فأمَّا ما يتخيّلونه من أن معنى ذلك: أن
القليلَ من النحو يُغني، وأن الكثيرَ منه يُفسد الكلام كما يُفسد الملحُ الطعامَ
إذا كثر فيه تحريفٌ، وقولٌ بما لا يتحصَّل على البَحْث، وذلك أنه لا يُتَصَوّر
الزيادةُ والنقصانُ في جريان أحكام النحو في الكلام، ألا ترَى أنه إذا كان من حكمه
في قولنا: كان زيدٌ ذاهباً، أن يُرفَع الاسم ويُنصَب الخبر، لم يخلُ هذا الحكم من
أن يوجد أو لا يوجد، فإن وُجد فقد حصل النحوُ في الكلام، وعَدَلَ مِزاجَهُ به،
ونُفِي عنه الفسادُ، وأنْ يكون كالطعام الذي لا يَغْذُو البدن وإن لم يوجد فيه
فَهُو فاسدٌ كائن بمنزلة طعام لم يُصلح بالملح، فسامعه لا ينتفع به بل يستضرُّ،
لوقوعه في عمياء وهجوم الوحشة عليه، كما يوجبه الكلام الفاسد العاري من الفائدة،
وليس بين هاتين المنزلتين واسطةٌ يكون استعمالُ النحو فيها مذموماً وهكذا القول في
كلِّ كلام، وذلك أن إصلاح الكلامِ الأول بإجرائه عل حكم النحو، لا يُغْني عنه في
الكلام الثاني والثالث، حتى يُتوَّهم أن حصولَ النحوِ في جملة واحدة من قصيدة أو
رسالة يُصلح سائر الجمل، وحتى يكون إفراد كل جُملة بحكمها منه تكريراً له وتكثيراً
لأجزائه، فيكون مَثَلُهُ مَثَل زيادة أجزَاء الملح على قدر الكفاية. وكذلك لا
يُتصور في قولنا: كان زيد منطلقاً، أن يتكرَّرَ هذا الحكم ويتكثّر على هذا الكلام،
فيصير النحو كذلك موصوفاً بأن لَهُ كثيراً هو مذمومٌ، وأن المحمودَ منه القليلُ،
وإنما وَزَانه في الكلام وِزَانُ وقوف لسان الميزان حتى يُنبئ عن مساواة ما في إحدى
الكفتين ما في الأخرى، فكما لا يُتصور في تلك الصفة زيادةٌ ونقصان، حتى يكون
كثيرُها مذموماً وقليلها محموداً، كذلك الحكم في الصِّفة التي تحصل للكلام بإجرائه
على حكم النحو ووَزْنِهِ بميزان، فقول أبي بكر الخوارزمي: "والبُغْضُ عِنْدِي كثرةُ
الإعراب" كلامٌ لا يُحصَل منه على طائل، لأنّ الإعراب لا يقع فيه قلة وكثرة، إن
اعتبرنا الكلام الواحد والجملة الواحدة، وإن اعتبرنا الجُمُل الكثيرةَ وجعلنا إعراب
هذه الجملة مضموماً إلى إعراب تلك، فهي الكثرة التي لا بدّ منها، ولا صلاح مع
تركها، والخليقُ بالبُغْض مَنْ ذَمَّها وإن كان أراد نحو قول الفرزدق:
وَمَا مِثْلُه في النّاس إلاَّ مملَّكاً أبو أمِّه حيٌّ
أبُوه يُقَـارِبُـهُ
موضوعاً على التأويلات المتكلَّفة، فليس ذلك بكثرةٍ وزيادة في الإعراب، بل هو بأن
يكون نَقْصاً له ونقضاً أولى، لأن الإعراب هو أن يُعرب المتكلم عما في نفسهُ
ويبيّنه ويوضِّح الغرض ويكشفَ اللَّبْسَ، والواضعُ كلامه على المجازفة في التقديم
والتأخير زائلٌ عن الإعراب، زائغٌ عن الصواب، متعرّض للتلبيس والتعمية، فكيف يكون
ذلك كثرةً في الإعراب? إنما هو كثرة عناءٍ على من رام أن يردَّه إلى الإعراب، لا
كثرة الإعراب، وهذا هو كالاعتراض على طريق شجون الحديث، ويُحتاج إليه في أصل كبير،
وهو أن من حق العاقل أن لا يتعدَّى بالتشبيه الجهةَ المقصودةَ، ولا سيما في
العقليات، وأرجع إلى النَّسَق، مثال "الأصل الثالث"، وهو أخذ الشبه من المعقول
للمعقول، أوَّل ذلك وأعمُّه تشبيهُ الوجودِ من الشيءٍ مرةً بالعدمَ، والعدمِ مرةً
بالوجود، أمّا الأول: فعلى معنى أنه لما قَلَّ في المعاني التي بها يظهر للشيء
قَدْرٌ، ويصير له ذِكْرٌ، صار وُجوده كلا وجود، وأمّا الثاني فعلى معنى أن الفاني
كان موجوداً ثم فُقِد وعُدم، إلا أنه لما خلّف آثاراً جميلةً تُحيي ذكرَه، وتُديم
في الناس اسمه، صار لذلك كأنه لم يُعدَم، وأما ما عدَاهما من الأوصاف فيجيء فيها
طريقان: أحدهما: هذا وذلك في كلّ موضع كان موضوع التشبيه فيه على ترك الاعتداد
بالصفة، وإن كانت موجودة، لخلوِّها مما هو ثمرتها والمقصودُ منها، والذي إذا خَلَتْ
منه لم تستحق الشَّرَف والفضلَ. تفسير هذا: أنك إذا وصفت الجاهل بأنه مّيت، وجعلت
الجهل كأنه موتٌ، على معنى أن فائدة الحياة والمقصود منها هو العلم و الإحساس، فمتى
عَدِمَهما الحيُّ فكأنه قد خرج عن حُكمْ الحيّ، ولذلك جُعل النَّوم موتاً، إذ كان
النائم لا يشعر بما بحضرته، كما لا يشعر الميِّت،والدرجة الأولى في هذا أن
يقال: فلان لا يعقل و هو بهيمة و حمار وما أشبه ذلك، مما يحطُّه عن معاني المعرفة
الشريفة، ثم أن يقال: فلان لا يعلم ولا يَفْقَهُ ولا يحسُّ، فيُنفَى عنه العلم
والإحساس جملةً لضعف أمره فيه، وغلبة الجهل عليه، ثم يُجعَل التعريضُ تصريحاً
فيقال: هو ميّتٌ خارجٌ من الحياة و هو جماد، توكيداً وتناهياً في إبعاده عن العلم
والمعرفة، وتشدُّداً في الحكم بأنْ لا مطمع في انحسار غَيَاية الجهل عنه، وإفاقته
مما به من سَكْرة الغيّ والغَفْلة وأن يُؤثِّر فيه الوعظ والتنبيهُ، ثم لما كان هذا
مستقراً في العادة، أعني جَعْلَ الجاهِل ميِّتاً، خرج منه أن يكون المستحقُّ لصفة
الحياة هو العالمَ المتيقظ لوَجْه الرُّشد، ثم لمّا لم يكن علمٌ أشرف وأعلى من
العِلم بوحدانية اللّه تعالى، وبما نزّله على النبيّ صلى الله عليه وسلم، جُعل من
حصل له هذا العلم بعد أن لم يكن، كأنه وَجَد الحياة وصارت صفةً له، مع وجود نور
الإيمان في قلبه، وجُعل حالته السابقةُ التي خلا فيها من الإيمان كحالة الموت التي
تُعدَم معه الحياة، وذلك قوله تعالى: "أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتَاً فَأَحْيَيْنَاهُ"
"الأنعام:221"، وأشباه ذلك، من هذا الباب قولهم: فلان حيٌّ و حيُّ القلب يريدون أنه
ثاقبُ الفهم جيِّد النظر، مستعدٌّ لتمييز الحق من الباطل فيما يَرِد عليه، بعيدٌ من
الغفلة التي كالموت ويذهبون به في وجه آخر، وهو أنه حَرِكٌ نافذٌ في الأمورِ غيرُ
بطيءِ النهوض وذلك أن هذه الأوصاف من أمارات الصحة واعتدال المزاج وتوقُّد نار
الحياة، وهذا يصلح في الإنسان والبهيمة، لأنه تعريض بالقدرة والقوة، والمذهب الأول
إشارة في العلم والعقل، وكلتا الصفتين أعني القدرة والعلم مما يشرف به الحيُّ، ومما
يضادُّه الموتُ وينافيه، ولما كان الأمْرُ كذلك صار إطلاق الحياة مرة عبارةً عن
العلم، وأخرى عن القدرة وإطلاقُ الموت إشارةً إلى عدم القدرة وضعفها تارةً، وإلى
عدم العلم وضعفه أخرى، والقول الجامع في هذا: أنّ تنزيلَ الوُجود منزلة العدَم إذا
أريد المبالغة في حطّ الشيء والوَضْع منه وخروجِه عن أن يُعتدَّ به، كقولهم: هو
والعدم سواء معروفٌ متمكن في العادات، وربما دعاهم الإيغال وحُبُّ السَّرَف إلى أن
يطلبوا بعد العدم منزلةً هي أدْوَن منه، حتى يقعُوا في ضرب من التهوّس، كقول أبي
تمام: وأنت أنْزَرُ من لا شيءَ في العددِ
مازِلْتُ أعطِفُ أيَّامِي فتمنَحُني نَيلاً أدَقَّ
من المعدومِ في العدَمِ | |
|
ebrehim
مدير

عدد المساهمات : 2239
تاريخ التسجيل : 19/10/2011
 |  موضوع: الاستعارة المفيدة موضوع: الاستعارة المفيدة  الثلاثاء 12 يونيو 2012, 18:03 الثلاثاء 12 يونيو 2012, 18:03 | |
| ويتفرع على هذا إثبات الفضيلة
للمذكور بإثبات اسم الشيء له، ويكون ذلك على وجهين: أحدهما: أن تريد المدحَ
وإثباتَ المَزِيَّة والفضل على غاية المبالغة، حتى لا تحصل عليه مزيداً، فإذا أردتَ
ذلك جعلتَ الإثبات كأنه مقصور عليه لا يُشارَك فيه، وذلك قولك: هذا هو الشيء وما
عداه فليس بشيءٍ، أي: إن ما عداه إذا قيس إليه صَغُر وحَقُر حتى لا يدخل في اعتداد،
وحتى يكونَ وِجْدَانه كفِقْدَانهُ، فقد نزّلت الوجود فيمن عدا المذكور منزلةَ
العدم، وأما أن يكون التفضيل على توسُّط، ويكون القصدُ الإخبار بأنه غير ناقص على
الجملة، ولا مُلْغًى منزَّل منزلةَ المعدوم، وذلك قولك: هذا شيءٌ، أي: داخل في
الاعتداد، وفي هذه الطريقة أيضاً تفاوُتٌ، فإنك تقول مرةً: هذا إمَّا لا، شيءٌ،
تريد أن تقول: إن الآخر ليس بشىء ولا اعتداد به أصلاً، وتقول أخرى: هذا شيء، تريد:
شيءٌ له قَدْرٌ وخَطَر، وتجرِي لك هذه الوجوه في أسماء الأجناس كلها تقول: هذا هو
الرجل ومَنْ عَداه فليس من الرجولية في شيء، و هذا هو الشعر فحسب، تبالغ في
التفضيل، وتجعل حقيقة الجنسية مقصورةً على المذكور، وتقول: هذا رجلٌ تريد: كاملٌ من
الرجال، لا أن مَنْ عَدَاه فليس برجل على الكمال، وقد تقول: هذا إمّا لا، رَجلٌ،
تريد: يَستحقّ أن يُعَدَّ في الرجال، ويكون قصدُك أن تشير إلى أنّ هناك واحداً آخرَ
لا يدخل في الاعتداد أصلاً ولا يستحق اسم الرجل، وإذا كان هذا هو الطريقَ المَهْيَع
في الوَضْع من الشيء وتركِ الاعتداد به، والتفضيل له والمبالغة في الاعتداد به، فكل
صفتين تضادّتا، ثم أُريد نَقص الفاضلة منهما، عبّر عن نقصها باسم ضدّها، فجُعلت
الحياة العارية من فضيلة العلم والقدرة موتاً، والبصر والسمعُ إذا لم ينتفع صاحبهما
بما يَسْمَع ويُبْصِر فلم يَفْهم معنى المسموع ولم يعتبر بالمُبصر أو لم يعرف
حقيقته عمًى وصَمَمَاً، وقيل للرجل: هو أعمى أصمُّ، يراد أنه لا يستفيد شيئاً مما
يسمع ويُبصر، فكأنه لم يسمع ولم يبصر، وسواءٌ عبّرت عن نقص الصفة بوجود ضدّها، أو
وصفِها بمجرَّد العدم، وذلك أنّ في إثبات أحد الضدّين وصفاً للشيء، نفياً للضدّ
الآخر، لاستحالة أن يوجدا معاً فيه، فيكون الشَّخص حيّاً ميّتاً معاً، أصمَّ سمعياً
في حالة واحدة، فقولك في الجاهل: هو ميّت، بمنزلة قولك: ليس بحيّ، وأن الوجود في
حياته بمنزلة العَدم. هذا هو ظاهر المذهب في الأمر والحكم إذا أُطلق القولُ، فأما
إذا قُيِّد كقوله: "أَصَمُّ عَمَّا سَاءَه سَمِيعُ" فَتُثْبَتُ له الصفتان معاً على
الجملة، إلاّ أن مرجع ذلك إلى أن يقال إنه كان يفقد السمع في حال ويعود إليه في حال
أو أنه في حقّ هذا الجنس فاقد الإدراك مسلوبه، وفيما عداه كائن على حكم السميع، فلم
يثبت له الصمم على الجملة، إلاّ للحكم بأن وجود سَمْعه كالعدم، إلا أن ذلك في شيء
دون شيء، وعلى التقييد دون الإطلاق، فقد تبيَّن أن أصل هذا الباب تنزيل الموجود
منزلة المعدوم، لكونه بحيث لا يعتدُّ به وخلِّوه من الفضيلة، والطريق الثاني في
شَبَه المعقول من المعقول: أن لا يكون على تنزيل الوُجود منزلة العدم، ولكن على
اعتبار صفة معقولةٍ يُتصوَّر وُجودها مع ضِدّ ما استعرتَ اسمه، فمن ذلك أن يراد
وَصْفُ الأمر بالشدة والصعوبة، وبالبلوغِ في كونه مكروهاً إلى الغاية القُصْوَى،
فيقال: لَقِيَ الموت، يريدون لَقَي الأمر الأشدَّ الصعب الذي هو في كراهة النَّفس
له كالموت، ومعلومٌ أنَّ كون الشيء شديداً صعباً مكروهاً صفةٌ معلومةٌ لا تُنافي
الحياة، ولا يُمْنَع وجودها معه، كما يُمنَع وجود المَوت مع الحياة ألا ترى أن
كراهة الوتِ موجودةٌ في الإنسان قبل حصوله، كيف وأكرهُ ما يكون الموت إذا صَفَتْ
مشاعر الحياة، وخَصِبتْ مسارح اللذّات، فكلما كانت الحياةُ أمكن وأتمّ، كانت
الكراهة للموت أقوى وأشدّ، ولم تخفَّ كراهته على العارفين إلا لرغبتهم في الحياة
الدائمة الصافية من الشوائب، بعد أن تزول عنه هذه الحياة الفانية ويُدركهم الموت
فيها، فتصوُّرُهم لذّة الأمْن منه، قلَّل كراهتهم له، كما أن ثقةَ العالم بما
يُعْقِبه الدواءُ من الصحة، تُهوّن عليه مَرَارَته، فقد عبْرت ها هنا عن شدّة الأمر
بالموت، واستعرته له من أجلها، والشّدةُ ومحصُولُها الكراهة، موجودة في كل واحد من
المستعار له والمستعار منه فليس التشبيه إذَنْ من طريق الحُكْم على الوجود بالعدم،
وتنزيل ما هو موجود كأنه قد خَلَعَ صفة الوجود، وذلك أن هذا الحكم إنما جرى في
تشبيه الجهل بالموتِ، وجعل الجاهل ميّتاً من حيث كان للجهل ضدٌُّ يُنافي الموت
ويضادُّه وهو العلم، فلما أردتَ أن تبالغ في نفي العلم الذي يجب مع نفيه الجهلُ،
وجعلتَ الجهلَ موتاً لتُؤْيس من حصول العلم للمذكور، وليس لك هذا في وصف الأمر
الشديد المكروه بأنه موت، ألا ترى أن قوله:ه قد خَلَعَ صفة الوجود، وذلك أن هذا
الحكم إنما جرى في تشبيه الجهل بالموتِ، وجعل الجاهل ميّتاً من حيث كان للجهل ضدٌُّ
يُنافي الموت ويضادُّه وهو العلم، فلما أردتَ أن تبالغ في نفي العلم الذي يجب مع
نفيه الجهلُ، وجعلتَ الجهلَ موتاً لتُؤْيس من حصول العلم للمذكور، وليس لك هذا في
وصف الأمر الشديد المكروه بأنه موت، ألا ترى أن قوله: لا تحسَبَنَّ المَوْتَ مَوْتَ البِلَى وإنما الموتُ
سُؤالُ الرجالْ
ينافي الموت أو يضادّه على الحقيقة، وأن هذا القائل قصد بجعل السؤال موتاً نَفْىَ
ذلك الضدّ، وأن يُؤْيِس من وجوده وحصوله، بل أراد أن في السؤال كراهة ومرارةً مثل
ما في الموت، وأن نفس الحرّ تنفِرُ عنه كما تنفر نفوسُ الحيوان جملةً من الموت،
وتطلبُ الحياةَ ما أمكن في الخلاص منه، فإن قلتَ: المعنى فيه أن السؤال يَكْسِب
الذُلَّ ويَنْفي العِزَّ، والذليلُ كالميت لفقد القدرة والتصرّف، فصار كتسميتهم
خُمول الذكر موتاً، والذكرَ بعد الموت حياةً، كما قال أمير المؤمنين علي رضي اللّه
عنه: مات خُزَّان المالِ، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مَفْقودة، وأمثالهم
في القلوب موجودة، قلتُ: إني آنَسُ أنهم لم يقصدوا هذا المعنى في السؤال، وإنما
أرادوا الكراهة، ولذلك قال بعد البيت الذي كتبته: كِلاَهما موتٌ، ولكـنَّ ذَا أشدُّ مِنْ ذاك
لذُلّ السُّؤالْ
بالموت لأنه يُكْرَه ويَصْعُب ولا يستسلم له العاقل إلاّ بعدَ أن تُعْوِزَه
الحِيَلُ فإنه يُحْمل هذا المَحْمَل، وينقادُ لهذا التأويل، أترى المتنبي في قوله:
وقد مُتّ أمْسِ بهـا مَـوْتَةً ولا يَشْتَهِي
الموتَ مَنْ ذَاقَهُ
شِدّةً، وأمَّا العبارة عن خمول الذكر بالموت، فإنه وإن كان يدخل في تنزيل الوجود
منزلة العدم، من حيث يقال: إن الخامل لمّا لم يُذكَر ولم يَبِنْ منه ما يُتحدَّث
به، صار كالميت الذي لا يكون منه قولٌ، بل ولا فعل يدلُّ على وجوده فليس دخوله فيه
ذلك الدخولَ، وذلك أن الجهل يُنافي العلم ويضادُّه كما لا يخفى، والعلم إذا وُجد
فَقَدْ وُجدت الحياةُ حَتْمَاً واجباً، وليس كذلك خمولُ الذكر والذكرُ، لأنه ليس
إذا وُجد الذكرُ فقد وُجدت الحياة، لأنك تُحدِّث عن الميت بأفعاله التي كانت منه في
حال الحياة، فيَتَصَوَّر الذكرُ ولا حياة على الحقيقة، ولا يُتَصَوَّر العلم ولا
حياة على الحقيقة. وهكذا القول في الطرف الآخر، وهو تسميةُ مَنْ لا يَعلم ميّتاً،
وذلك أن الموت ها هنا عبارة عن عَدَم العلم وانتفائه، وعدم العلم على الإطلاق، حتى
لا يوجد منه شيء أصلاً، وحتى لا يصحّ وجوده، يقتضي وجود الموت على الحقيقة ولا يمكن
أن يقال إنّ خمولَ الذكر يوجب الموت على الحقيقة، فأنت إذن في هذا تُنزّل الوجود
منزلةَ العدم على وجهٍ لا ينصرف إلى الحقيقة ولا يصير إليها،، وإنما يُمثَّل
ويُخيَّل، وأما في الضرب الأول وهو جعلُ من لا يعلم ميِّتاً ومن يعَلم هو الحيّ
فإنك تلاحظ الحقيقة وتشير إليها وتحطِب في حَبْلها فاعرفه. وأمَّا قولهم في الغنيّ
إذا كان بخيلاً لا ينتفع بماله: إنّ غناه فقر، فهو في الضرب الأول أعني تنزيلَ
الوجود منزلة العدم لتعرّى الوجود مما هو المقصود منه، وذلك أن المال لا يُراد
لذاته، وإنما يُراد للانتفاع به في الوجوه التي تعدُّها العقلاء انتفاعاً، فإذا
حُرم مالكه هذه الجدوى وهذه الفائدة، فملْكُه له وعدم الملك سواء، والغِنَي إذا
صُرف إلى المال، فلا معنى له سوى مِلْك الإنسان الشيء الكثير منه، ألا تراه يُذكَر
مع الثروة فيقال: غنيٌّ مُثْرٍ مُكثر? فإذا تبين بالعلة التي مضت أنه لا يستفيد
بمِلْكه هذا المالَ معنًى، وأن لا طائل له فيه، فقد ثبت أن غِناه والفقرَ سواء، لأن
الفقر أن لا يملك المال الكثير، وأمّا قول اللُؤَماء: إن انتفاعه في اعتقاده أنَّه
متى شاء انتفع به، وما يجد في نفسه من عزّة الاستظهار، وأنه يُهاب ويُكْرم من أجله،
فمن أضاليل المُنَى، وقد يُهان ويُذَّلُّ ويُعَذَّب بسببه حتى تُنْزَع الروح دونه،
ثم إن هذا كلامٌ وضعه العقلاء الذين عرفوا ما الانتفاع، وهذا المخالفُ لا يُنكر أن
الانتفاع لو عُدم كان مِلكه الآن لمالٍ وعَدَمُ ملكه سواءٌ، وإنما جاء يتطلّب
عُذْراً، ويُرخِي دون لُؤْمه سِتْراً، ونظير هذا أنك ترى الظالم المجترئ على
الأفعال القبيحة، يدّعي لنفسه الفضيلة بأنه مَدِيد الباع طويلُ اليد، وأنه قادرٌ
على أن يُلجئ غيره إلى التَّطامن له، ثم لا يزيده احتجاجُه إلا خِزْياً وذُلاً عند
اللّه وعند الناس، وترى المصدِّق له في دعواه أذَمَّ له وأهجى من المكذِّب، لأن
الذي صدّقه أيِسَ من أن ينزع إلى الإنسانية بحالٍ، والذي كذَّب رجَا أن ينزع عند
التنبيه والكشف عن صورة القبيح، وأما قولهم في القناعة إنها الغِنَى كقوله:
إنَّ القُنوعَ الغِنَى لا كثرةُ المال
الآخر: إنّ القَنَاعةَ فاعلمـنَّ غِـنَـى والحِرْصُ
يُورِث أهلَهُ الفَقْرَا
كان شَرِهاً حريصاً على الازدياد، فقيراً، فمِمَّا يرجع إلى الحقيقة المحضة، وإن
كان في ظاهر الكلام كالتشبيه والتمثيل، وذلك أن حقيقة الغِنَى هو انتفاء الحاجة
والحاجة أن تريد الشيء ولا تجدُه، والكثير المال إذا كان الحِرْصُ عليه غالباً،
والشَّرَهُ له أبداً صاحباً، كان حاله كحال من به كَلَبُ الجوع يأكل ولا يشبع، أو
من به البَغَرُ يشرب ولا يروَى، فكما إنّ إصابته من الطعام والشراب القدرَ الذي
يُشبع ويُروى، إذا كان المزاج معتدلاً والصّحة صحيحةً، لا تنفي عنه صفة الجائع
والظمآنِ لوجود الشهوة ودَوامِ مُطالبة النفس وَبَقَاء لهيب الظمأِ وجهْدِ العطش،
كذلك الكثيرُ المال لا تحصل له صفة الغِنى ولا تزول عنه صفة الفقر، مع بقاء حرصه
الذي يُديم له القَرَم والشَّره والحاجة والطلَب والضَجَر حين يفقِد الزيادة التي
يريدها، وحين يفوته بعض الرِّبح من تجاراته وسائر متصرَّفاته، وحتى لا يكاد يفصِل
بين حاله وقد فاته ما طلب، وبينها وقد أُخذ بعض مالِهِ وغُصب، ومن أين تحصُل حقيقة
الغِنَى لذي المال الكثير? وقد تراه من بُخله وشُّحِّه كالمقيَّد دون ما ملكه،
والمغلول اليدِ يموت صبراً ويُعاني بؤساً، ولا تمتّد يدُه إلى ما يزعمُ أنه يملكه
فيُنفقه في لذَّة نفسٍ، أو فيما يَكْسِب حمداً اليوم وأجراً غداً، ذاك لأنه عَدِم
كرماً يبسُط أناملَه، وجُوداً ينصر أمَلَهُ، وعقلاً يبصّره، وهمّةً تمكنّه مما
لديه، وتُسلِّطه عليه، كما قال البحتري: ووَاجِدُ مالٍ أعوزَتْهُ سَجِـيّةٌ تُسلّطه يوماً
على ذلك الوُجْد
الغِنَى لا كثرة المال، إخبار عن حقيقةِ نفّذتها قضايا العقول، وصحّحتها الخِبرة
والعِبرة، ولكن رُبّ قضيةٍ من العقل نافذةٍ قد صارت كأنها من الأمور المتجوَّز
فيها، أو دون ذلك في الصحة، لغلبة الجهل والسَفَه على الطباع، وذهاب من يعمل بالعقل
ويُذعن له، ويطرح الهوى، ويصبُو إلى الجميل، ويأنَف من القبيح، ولذهاب الحياء
وبُطلانه، وخروج الناس من سُلْطانه، ويأس العاقل من أن يُصادف عندهم، إن نَبَّهَ أو
ذَكَّر، سمعاً يعي، وعقلاً يراعي، فجَرْيُ الغنى على كثرة المال، والفقر على قلّته،
مما يُزيله العُرف عن حقيقته في اللغة، ولما كان الظاهرُ من حال الكثير المال أنه
لا يَعْجِز عن شيء يريده من لذّاته وسائر مطالبه، سُمّي المال الكثير غِنًى، وكذلك
لمَّا مَن كان قَلَّ ماله، عَجَز عن إرادته، سُمّي قلّة المال فقراً، فهو من جنس
تسمية السبب باسم المسَبَّب، وإلا فحقيقة الغنى انتفاء الاحتياج، وحقيقة الفقر
الاحتياج، واللّه تعالى الغنيُّ على الحقيقة، لاستحالة الاحتياج عليه جلّ وتعالى عن
صفات المخلوقين، على ذاك ما جاء في الخبر من أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال:
"أَتَدْرُون من المفلس? قالوا: المفلس فينا يا رسول اللّه من لا دِرْهمَ له ولا
مَتَاع، قال: المفلس من أُمَّتي من يأتي يوم القيامة بصلاته وزكاته وصيامه، فيأتي
وقد شتم هذا وأكل مال هذا وقَذَف هذا وضرب هذا وسفك دمَ هذا فيُعطَى هذا من حسناته،
وهذا من حسناته، فإن فنيتُ حسناته قبل أن يفنى ما عليه من الخطايا، أُخذ من خطاياهم
فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار"، ذاك أنه صلى الله عليه وسلم بيَّن الحكم في
الآخرة، فلما كان الإنسان إنما يُعَدُّ غنيّاً في الدنيا بماله، لأنه يجتلب به
المسرّة ويدفع المضرّة، وكان هذا الحكم في الآخرة، للعمل الصالح، ثبتَ لا محالة أن
يكون الخاليِ، نعوذ باللّه، من ذلك، هو المفلس، إذ قد عَرِيَ مما لأجله يسمّى
الخالي من المال في الدنيا مفلساً، وهو عدم ما يوصله إلى الخير والنعيم، ويقيه
الشرَّ والعذابَ، نسأل اللّه التوفيق لما يُؤْمِنُ من عقابه. وإذا كان البَحْثُ
والنظر يقتضي أن الغنى و الفقر في هذا الوجه دالاّن على حقيقة هذا التركيب في
اللغة، كقولك: غَنِيتُ عن الشيء و استغنيتُ عنه، إذا لم تحتج إليه و افتقرتُ إلى
كذا، إذا احتجتَ إليه وجب أن لا يعدواها ها هنا في المستعار والمنقول عن
أصله.إن قال قائل: إنّ تنزيل
الوجود منزلةَ العدم، أو العدِم منزلةَ الوجود، ليس من حديث التشبيه في شيء، لأن
التشبيه أن تثبت لهذا معنًى من معاني ذاك، أو حُكماً من أحكامه، كإثباتك للرجل
شجاعة الأسد، وللحُجة حكم النُّور، في أنك تفصل بها بين الحق والباطل، كما يُفصل
بالنور بين الأشياء، وإذا قلت في الرجل القليل المعاني: هو معدوم، أو قلت: هو و
العدم سواء، فلست تأخذ له شبهاً من شيء، ولكنك تنفيه وتُبطل وجوده، كما أنك إذا
قلت: ليس هو بشيء أو ليس برجل، كان كذلك، وكما لا يسمّى أحدٌ نحوَ قولنا: ليس بشيء
تشبيهاً، كذلك ينبغي أن لا يكون قولك: وأنت تقلِّل الشيءَ أُخبرت عنه معدومٌ
تشبيهاً، وكذلك إذا جعلت المعدوم موجوداً كقولك مثلاً للمال يذهب ويفنَى ويُثمر
صاحبهُ ذكراً جميلاً وثناءً حسناً: إنه باقٍ لك موجود، لم يكن ذلك تشبيهاً، بل
إنكاراً لقول من نفى عنه الوجود، حتى كأنك تقول: عينُه باقية كما كانت، وإنما
استَبْدَل بصورة صورةً فصار جمالاً، بعد ما كان مالاً، ومكارمَ، بعد أن كان دراهم،
وإذا ثبت هذا في نفس الوُجود والعدم، ثبت في كل ما كان على طريق تنزيل الصفة
الموجودة كأنها غير موجودة، نحو ما ذكرت من جعل الموت عبارةً عن الجهل، فلم يكن ذلك
تشبيهاً، لأنه إذا كان لا يُرَاد بجعل الجاهل ميّتاً إلا نفْي الحياة عنه مبالغةً ،
ونفيُ العلم والتمييز والإحساس الذي لا يكون إلا مع الحياة، كان محصوله أنك لم
تعتدُّ بحياته، وتركُ الاعتداد بالصفة لا يكون تشبيهاً، إنما نفيٌ لها وإنكارٌ لقول
من أثبتها، فالجواب: إن الأمر كما ذكرتَ، ولكنّي تتبّعتُ فيما وضعتُه ظاهرَ الحال،
ونظرتُ إلى قولهم: موجود كالمعدوم، وشيءٌ كلا شيء، ووجود شبيه بالعدم، فإن أبيتَ أن
تعمل على هذا الظاهر لم أضايق فيه، إلا أن من حَقّك أن تعلم أنه لا غِنَى بك عن حفظ
الترتيب الذي رتَّبْتُه في إعطاء المعقول اسم معقول آخر أعني لا بدّ من أن تعلم أنه
يجيء على طريقين: أحدهما: تنزيل الوجود منزلة العدم، كما مضى من أنّ جعل الموت
عبارةً عن الجهل، وإيقاعُ اسمه عليه يرجع إلى تنزيل حياته الموجودة كأنها معدومة،
والثاني: أن لا يكون هذا المعنى، ولكن على أنّ لأحد المعنيين شَبَهَاً من الآخر،
نحو أن السؤال يُشبه، في كراهته وصُعوبته على نفس الحُرّ، الموتَ. واعلم أني ذكرت
لك في تمثيل هذه الأصول الواضحَ الظاهرَ القريبَ المتناوَلِ الكائنَ من قَبِيل
المتعارف في كل لسان، وما تجد اعترافاً به وموافقةً عليه من كل إنسان، أو ما يشابه
هذا الحدَّ ويشاكله، ويداخل هذا الضَّرب ويشاركه، ولم أذكر ما يدِقُّ ويغمُض،
ويلطُف ويَغْرُب، وما هو من الأسرار التي أثارتْها الصنعة، وغاصت عليها فكرة
الأفراد من ذوي البراعة في الشِّعر، لأن القصد إذا كان لتمهيد الأساس، ووضع قواعد
القياس، كان الأوْلى أن أعمدَ إلى ما هو أظهر وأجلى من الأمثلة، لتكون الحجةُ بها
عامّة لا يصرف وجهها بحال، والشهادةُ تامةً لا تجد من السامعين غير قبول وإقبال،
حتى إذا تمّهدَت القواعد، وأُحكمت العُرَى والمَعَاقد، أُخِذ حينئذ في تتبُّع ما
اخترعته القرائح، وعُمِد إلى حل المشكلات عن ثقةٍ بأنْ هُيّئَت المفاتح، هذا وفي
الاستعارة بعدُ من جهة القوانين والأصول، شغلٌ للفكر، ومذهب للقول، وخفايا ولطائفُ
تُبْرَز من حُجُبِها بالرِّفْق والتدريج والتلطُّف والتأنِّي، ولكني أظنُّ أنَّ
الصوابَ أن أنْقُلَ الكلام إلى القول على التشبيه والتمثيل وحقيقتهما والمراد
منهما، خصوصاً في كلام من يتكلم على الشعر، ونتعرّف أهما متساويان في المعنى، أو
مختلفان، أم جنسهما واحدٌ، إلا أن أحدهما أخصُّ من الآخر ? وأنا أضع لك جملة من
القول تَبِين بها هذه الأمور، | |
|