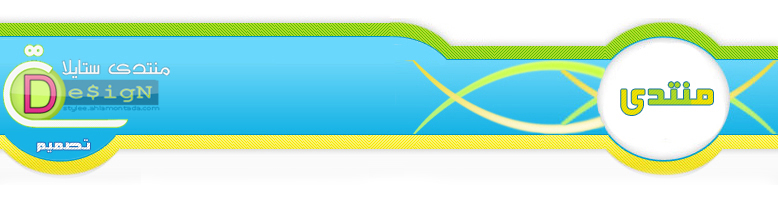ebrehim
مدير

عدد المساهمات : 2239
تاريخ التسجيل : 19/10/2011
 |  موضوع: المجاز و بيان معناه وحقيقته موضوع: المجاز و بيان معناه وحقيقته  الثلاثاء 12 يونيو 2012, 18:51 الثلاثاء 12 يونيو 2012, 18:51 | |
| المجاز مَفْعَلٌ من جازَ
الشيءَ يَجُوزه، إذا تعدَّاه، وإذا عُدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة، وُصف بأنه
مجاز، على معنى أنهم جازوا به موضعَه الأصليَّ، أو جاز هو مكانه الذي وُضع فيه
أوَّلاً، ثُمَّ اعلم بَعْدُ أنَّ في إطلاق المجاز على اللفظ المنقول عن أصله شرطاً،
وهو أن يقع نَقْلُه علي وجهٍ لا يَعْرَى معه من ملاحظة الأصل، ومعنى الملاحظة، أن
الاسم يقع لما تقول إنه مجاز فيه، بسببٍ بينه وبين الذين تجعله حقيقةً فيه، نحو أن
اليد تقع للنعمة، وأصلها الجارحة، لأجل أن الاعتبارات اللغوية تتبع أحوال المخلوقين
وعاداتهم، وما يقتضيه ظاهر البِنْيَة وموضوع الجِبِلّة، ومن شأن النعمة أن تصدُر عن
اليد، ومنها تصل إلى المقصودِ بها، وفي ذكر اليد إشارةٌ إلى مَصْدَرِ تلك النعمةِ
الواصلةِ إلى المقصود بها، والموهوبةِ هي منه، وكذلك الحكم إذا أريد باليد القوة
والقدرة، لأن القدرة أثر ما يظهر سُلطانها في اليد، وبها يكون البطش والأَخذُ
والدفعُ والمنعُ والجذبُ والضربُ والقطعُ، وغيرِ ذلك من الأفاعيل التي تُخبر فَضْلَ
إخبارٍ عن وجوه القُدْرة، وتُنبئ عن مكانها، ولذلك تجدهم لا يريدون باليد شيئاً لا
ملابسة بينه وبين هذه الجارحة بوجهٍ. ولوجوب اعتبار هذه النكتة في وصف اللَّفْظ
بأنه مجاز، لم يَجُز استعماله في الألفاظ التي يقع فيها اشتراك من غير سبب يكون بين
المشترِكَيْن، كبعض الأسماء المجموعة في المَلاحن، مِثْلُ أن الثَّوْرَ يكون اسما
للقطعة الكبيرة من الأَقِطِ، والنهار اسمٌ لفرخ الحُبَارَى، والليل، لولد
الكَرَوان، كما قال: أكَلْتُ
النَّهار بِنِصْفِ النَّهارِ ولَيْلاً أكلتُ
بلَيْلٍ بَـهِـيم
الأقط لأمرٍ بينه وبين الحيوان المعلم، ولا النهار على الفرخ لأمْرٍ بينه وبين ضوء
الشمس، أدّاه إليه وساقه نحوه، والغرضُ المقصود بهذِه العبارة - أعني قولَنا:
المجازُ - أن نبيّن أن للَّفظ أَصلاً مبدوءاً به في الوضع ومقصوداً، وأنَّ جريه على
الثاني إنما هو على سبيل الحُكْم يتأدَّى إلى الشيء من غيره، وكما يعبَق الشيءُ
برائحةِ مايجاورُه، وَينْصَبغ بلونِ ما يدانيه، ولذلك لم ترهم يُطلقون المجاز في
الأعلام، إطلاقَهم لفظ النَّقل فيها حيث قالوا: العَلَمُ على ضربين منقولٌ ومرتجلٌ،
وأن المنقول منها يكون منقولاً عن اسم جنسٍ، كأسد وثور وزيد وعمرو، أو صفةٍ، كعاصم
وحارث، أو فعل، كيزيد ويشكر أو صَوْتٍ كبَبَّة، فأثبتوا لهذا كله النَّقل من غير
العَلَمية إلى العلمية، ولم يروا أن يصِفُوه بالمجاز فيقولوا مثلاً: إن يشكر حقيقة
في مضارع شَكَرَ، ومجاز في كونه اسم رجل وأن حَجَراً حقيقة في الجماد، ومجازٌ في
اسم الرجل، وذلك أن الحجر لم يقع اسماً للرجل لالتباسٍ كان بينه وبين الصخر، على
حسب ما كان بين اليد والنعمة، وبينها وبين القدرة ولا كما كان بين الظَّهر الكامل
وبين المحمول في نحو تسميتهم المزادة راوية، وهي اسم للبعير الذي يحملها في الأصل
وكتسميتهم البعير حَفَضاً، وهو اسم لمتاع البيت الذي حُمَل عليه ولا كنحو ما بين
الجزء من الشخص وبين جملة الشخص، كتسميتهم الرجل عَيْناً، إذا كان ربيئةً، والناقةَ
ناباً ولا كما بين النَّبت والغيث، وبين السماء والمطر، حيث قالوا: رعينا الغيثَ،
يريدون النبتَ الذي الغيث سببٌ في كونه وقالوا: أصابنا السماء، يريدون المطر، وقال
"تَلُفُّهُ الأَرْوَاحُ والسُمِيُّ" وذلك أن في هذا كله تأوُّلاً، وهو الذي أفضى
بالاسم إلى ما ليس بأصل فيه فالعين لما كانت المقصودة في كون الرجل ربيئةً، صارت
كأنها الشخص كلُّه، إذْ كان ما عداها لا يُغنى شيئاً مع فقدها و الغيث، لمَّا كان
النبت يكون عنه، صار كأنه هو والمطر لما كان ينزل من السماء، عبروا عنه باسمها.
واعلم أن هذه الأسباب الكائنةَ بين المنقول والمنقول عنه، تختلف في القوة والضعف
والظهور وخلافه، فهذه الأسماء التي ذكرتها، إذا نظرتَ إلى المعاني التي وصلت بين ما
هي له، وبين ما رُدَّت إليه، وجدتها أقوى من نحو ما تراه في تسميتهم الشاةَ التي
تُذبَح عن الصبيِّ إذا حُلِقَتْ عقيقتُه، عقيقةً وتجد حالها بعدُ أقوى من حال
العَقِيرة، في وقوعها للصوت في قولهم: رَفع عقِيرته، وذلك أنَّه شيء جرى اتفاقاً،
ولا معنَى يصل بين الصَّوت وبين الرِجْل المعقورة، على أن القياس يقتضي أن لا
يسمَّى مجازاً، ولكن يُجرَى مُجْرَى الشيء يُحكَى بعد وُقُوعه، كالمَثَل إذا حُكَي
فيه كلامٌ صَدَر عن قائله من غير قَصْدٍ إلى قياس وتشبيه، بل للإخبار عن أمر مَن
قَصَده بالخطاب كقولهم: الصَّيْفَ ضَيَّعَتِ اللَّبن، ولهذا الموضع تحقيق لا يتمّ
إلاّ بأن يوضع له فصل مُفْرَدٌ. والمقصود الآن غير ذلك، لأن قصدي في هذا الفَصْل أن
أبيّن أن المجازَ أعمُّ من الاستعارة، وأن الصحيح من القضيّة في ذلك: أن كلَّ
استعارةٍ مجازٌ، وليس كلُّ مجازٍ استعارة، وذلك أنّا نرى كلامَ العارفين بهذا الشأن
أعني علم الخطابة ونَقْدِ الشعر، والذين وضعوا الكتب في أقسام البديع، يجري على أن
الاستعارة نقلُ الاسم من أصله إلى غيره للتشبيه على حدِّ المبالغة، قال القاضي أبو
الحسن في أثناء فَصْلٍ يذكرها فيه: ومِلاكُ الاستعارة، تقريب الشَّبه، ومناسبة
المستعار للمستعار منه، وهكذا تراهم يعدّونها في أقسام البديع، حيث يُذكر التجنيس
والتطبيق والترشيح وردُّ العجز على الصدر وغير ذلك، من غير أن يشترطوا شرطاً،
ويُعقِبُوا ذِكرَها بتقييد فيقولوا: ومن البديع الاستعارةُ التي من شأنها كذا،
فلولا أنها عندهم لنَقْل الاسم بشرط التشبيه على المبالغة، وإمَّا قَطْعاً وإمَّا
قريباً من المقطوع عليه، لما استجازوا ذكرها، مطلقةً غير مقيّدة، يبيِّن ذلك أنها
إن كانت تُساوِقُ المجازَ وتجري مَجْراه حتى تصلح لكل ما يصلح له، فذِكْرُها في
أقسام البديع يقتضي أن كل موصوف بأنه مجازٌ، فهو بديع عندهم، حتى يكون إجراءُ اليد
على النعمة بديعاً، وتسمية البعير حَفَضاً، والناقةِ ناباً، والربيئةِ عيناً،
والشاةِ عقيقةً، بديعاً كله، وذلك بيّن الفساد. وأمَّا ما تجده في كتب اللغة من
إدخال ما ليس طريقُ نقله التشبيه في الاستعارة، كما صنع أبو بكر بن دريد في
الجمهرة، فإنه ابتدأ بَاباً فقال: باب الاستعارات ثم ذكر فيه أن الوغَى اختلاط
الأصوات في الحرب، ثم كَثُر وصارت الحرب وَغىً، وأنشد:بديعاً كله، وذلك بيّن
الفساد. وأمَّا ما تجده في كتب اللغة من إدخال ما ليس طريقُ نقله التشبيه في
الاستعارة، كما صنع أبو بكر بن دريد في الجمهرة، فإنه ابتدأ بَاباً فقال: باب
الاستعارات ثم ذكر فيه أن الوغَى اختلاط الأصوات في الحرب، ثم كَثُر وصارت الحرب
وَغىً، وأنشد: إضْمَامَةٌ مِن
ذَوْدِها الثَّلاثينْ لَهَا وغًى
مِثْل وَغَى الثَّمانينْ
قولهم: رعَيْنَا الغيث والسَّماء، يعني المطر وذكر ما هو أبعد من ذلك فقال:
الخُرْس، ما تُطْعَمُه النُّفَساء، ثم صارت الدَّعوة للولادة خُرْساً والإعذار
الختان، وسُمّي الطعام للختان إعْذَاراً وأن الظعينة أصلها المرأة في الهَوْدَج، ثم
صار البعير والهودج ظَعِينَةً والخَطْرُ ضرب البعير بذنبه جانبي وَرِكيه، ثم صار
مالصِق من البول بالوركين خَطْراً، وذكر أيضاً الرَّاوية بمعنى المزادة، والعقيقةَ،
وذكر فيما بين ذِكْرِه لهذه الكلم أشياءَ هي استعارةٌ على الحقيقة، على طريقة أهل
الخطابة ونقد الشعر، لأنه قال: الظمأ، العطشُ وشهوةُ الماء، ثم كثر ذلك حتى قالوا:
ظمِئتُ إلى لقائك، وقال: الوَجُورُ ما أوجرته الإنسان من دَواءٍِ أو غيره، ثم
قالوا: أَوْجَره الرمحَ، إذا طعنه في فيه. فالوجه في هذا الذي رأوه من إطلاق
الاستعارة على ما هو تشبيه، كما هو شرط أهل العلم بالشعر، وعلى ما ليس من التشبيه
في شيءٍ، ولكنه نقلُ اللفظ عن الشيء إلى الشيء بسبب اختصاصٍ وضربٍ من الملابسة
بينهما، وخَلْطِ أحدهما بالآخر أنهم كانوا نظروا إلى ما يتعارفه الناس في معنى
العاريَّة، وأنها شيءٌ حُوِّل عن مالكه ونُقل عن مقرّه الذي هو أصلٌ في استحقاقه،
إلى ما ليس بأصل، ولم يُراعوا عُرْف القوم، ووِزانهم في ذلك وِزَانُ من يترك عُرف
النحويين في التمييز، واختصاصهم له بما احتمل أجناساً مختلفةً كالمقادير والأعداد
وما شاركهما، في أن الإبهام الذي يراد كشْفُه منه هو احتماله الأجناس، فيُسمِّي
الحالَ مثلاً تمييزاً، من حيث أنك إذا قلت: راكباً، فقد ميَّزت المقصود وبيّنته،
كما فعلت ذلك في قولك: عشرون درهماً ومَنَوَانِ سمناً وقَفِيزان بُرّاً ولي مثلُهُ
رجلاً وللَّه درَّه رجلاً. وليس هذا المذهب بالمذهب المرضيّ، بل الصواب أن تُقصَر
الاستعارة على ما نقْلُه نَقْلُ التشبيه للمبالغة، لأن هذا نقلٌ يَطّرد على حدٍّ
واحد، وله فوائد عظيمة ونتائج شريفة، فالتطفُلُ به على غيره في الذكر، وتركُه
مغموراً فيما بين أشياءَ ليس لها في نقلها مِثْلُ نظامه ولا أمثالُ فوائده، ضعفٌ من
الرأي وتقصيرٌ في النظر. وربما وَقع في كلام العلماء بهذا الشأن الاستعارةُ على تلك
الطريقة العامّية، إلا أنه لا يكون عند ذكر القوانين وحيث تُقرَّرُ الأصول، ومثاله
أن أبا القاسم الآمدي قال في أثناء فصل يُجيب فيه عن شيءٍ اعتُرض به على البحتري في
قوله: فكأَنَّ
مَجْلِسَهُ المُحجَّبَ مَحْفِلٌ وكأَنَّ
خَلْوَتَه الخفيَّةَ مَشْهَـدُ
إلاَّ وفيه قوم، ثم قال: ألا ترى إلى قول المُهَلْهل "واستَبَّ بَعْدَك يا كُلَيْبُ
المجلس" على الاستعارة، فأطلق لفظ الاستعارة على وقوع المجلس هنا، بمعنى القوم
الذين يجتمعون في الأمور، وليس المجلس إذا وقع على القوم من طريق التشبيه، بل على
حدِّ وقوع الشيء على ما يتَّصلُ به، وتكثُر ملابَستُه إياه، وأيُّ شبه يكون بين
القوم ومكانهم الذي يجتعون فيه? إلاّ أنه لا يُعتدُّ بمثل هذا فإنَّ ذلك قد يتَّفق
حيث تُرسَل العبارة، وقال الآدميُّ نفسه: ثم قد يأتي في الشعر ثلاثة أنواع أُخَر،
يكتسي المعنى العامّ بِها بهاءً وحسناً، حتى يخرج بعد عمومه إلى أن يصير مخصوصاً ثم
قال: وهذه الأنواع هي التي وقع عليها اسم البَديع، وهي الاستعارة والطباق والتجنيس.
فهذا نصٌّ في وضع القوانين على أن الاستعارة من أقسام البديع، ولن يكون النَّقلُ
بديعاً حتى يكون من أجل الشبيه على المبالغة كما بيَّنتُ لك، وإذا كان كذلك، ثم جعل
الاستعارة على الإطلاق بديعاً، فقد أعلمك أنها اسم للضرب المخصص من النَّقل دون
كُلِّ نَقْل فاعرف. واعلم أنَّا إذا أنعمنا النظر، وجدنا المنقول من أجل التشبيه
على المبالغة، أحقَّ بأن يوصف بالاستعارة من طريق المعنى، بيان ذلك أن مِلك
المُعِير لا يزول عن المستعار، واستحقاقُه إيّاه لايرتفع، فالعاريّة إنما كانت
عاريّةً، لأن يَدَ المستعير يدٌ عليها، ما دامت يدُ المعير باقية، ومِلْكه غيرُ
زائل، فلا يُتصوَّر أن يكون للمستعير تصرُّفٌ لم يستفده من المالك الذي أعاره، ولا
أنْ تستقرّ يدُه مع زوالِ اليد المنقول عنها، وهذه جملةٌ لا تراها إلاّ في المنقول
نقلَ التشبيه، لأنك لا تستطيع أن تتصوَّر جَرْيَ الاسم على الفَرْع من غير أن
تُحوِجَه إلى الأصل، كيف ولا يُعقَل تشبيهٌ حتى يكون هاهنا مشبّه ومشبَّه به، هذا
والتشبيه ساذَجٌ مُرْسل، فكيف إذا كان على معنى المبالغة، على أن يُجعل الثاني أنه
انقلب مثلاً إلى جنس الأوَّل، فصار الرجلُ أسداً وبَحراً وبدراً، والعلم نُوراً،
والجهلُ ظلمةً، لأنّه إذا كان على هذا الوجه، كانت حاجتُك إلى أن تنظر به إلى الأصل
أَمَسَّ، لأنه إذا لم يُتصوَّر أنْ يكون هاهنا سبعٌ من شأنه الجرأة العظيمةُ
والبطشُ الشديد، كان تقديرك شيئاً آخر تَحوَّلَ إلى صفته وصار في حكمه من أبعد
المُحال. وأمَّا ما كان منقولاً لا لأجل التشبيه، كاليد في نقلها إلى النعمة، فلا
يوجد ذلك فيه، لأنك لا تُثبت للنعمة بإجراء اسم اليد عليها شيئاً من صفات الجارحة
المعلومة، ولا تروم تشبيهاً بها ألبتة، لا مبالغاً ولا غير مبالغ، فلو فرضنا أن
تكون اليد اسماً وضع للنعمة ابتداءً، ثم نُقلت إلى الجارحة، لم يكن ذلك مستحيلاً،
وكذلك لو ادّعَى مدَّعٍ أنّ جَرْيَ اليدِ على النعمة أصلٌ ولغةٌ على حِدَتها، وليست
مجازاً، لم يكن مدَّعياً شيئاً يحيله العقلُ، ولو حاول مُحاولٌ أن يقول في مسألتنا
قولاً شبيهاً بهذا فرام تقدير شيءٍ يجري عليه اسم الأسد على المعنى الذي يريده
بالاستعارة، مع فقد السبُعِ المعلوم، ومن غير أن يسبقَ استحقاقه لهذا الاسم في وضع
اللغة، رام شيئاً في غاية البعد. وعبارةٌ أخرى العاريّة من شأنها أن تكون عند
المستعير على صفةٍ شبيهةٍ بصفتها وهي عند المالك، ولسنا نجد هذه الصورة إلا فيما
نُقل نَقْلَ التشبيه للمبالغة دون ما سواه، ألا ترى أن الاسم المستعار يتناول
المستعارَ له، ليدلَّ على مشاركته المستعار منه في صفةٍ هي أخصُّ الصفات التي من
أجلها وُضع الاسم الأول? أعني أن الشجاعة أقوى المعاني التي من أجلها سُمّي الأسد
أسداً، وأنت تستعير الاسم للشيء على معنى إثباتها له على حدّها في الأسد. فأما اليد
ونقلُها إلى النعمة، فليست من هذا في شيءٍ، لأنها لم تتناول النعمةَ لتدلَّ على صفة
من صفات اليد بحال، ويحرِّر ذلك نكتةٌ: وهي أنك تريد بقولك: رأيت أسداً، أن تُثبِتَ
للرجل الأسدية، ولست تريد بقولك: له عندي يَدٌ، أن تُثبت للنعمة اليديّة، وهذا
واضحٌ جدّاً. واعلم أنَّ الواجب كان أن لا أَعُدَّ وضع الشفةِ موضع الجحفلة،
والجحفلة في مكان المِشْفَر، ونظائره التي قدَّمتُ ذكرها في الاستعارة، وأضَنَّ
باسمها أن يقع عليه، ولكني رأيتُهم قد خَلَطوه بالاستعارات وعَدُّوه مَعَدَّها،
فكرِهتُ التشدّد في الخلاف، واعتددت به في الجملة، ونبَّهت على ضعف أمره بأن
سمّيتُه استعارةً غير مُفيدة، وكان وزان ذلك وِزان أن يقال: المفعول على ضربين
مفعول صحيح، ومشبّه بالمفعول، فيُتجوَّز باعتداد المشبَّه بالمفعول في الجملة، ثم
يفصل بالوصف، ووجهُ شَبَهِ هذا النحو الذي هو نَقْلُ الشفة إلى موضع الجحفلة
بالاستعارة الحقيقية، لأنك تنقل الاسم إلى مجانسٍ له، ألا ترى أنّ المراد بالشفة
والجحفلة عضوٌ واحد، وإنما الفرق أنّ هذا من الفَرَس، وذاك من الإنسان، والمجانسة
والمشابهة من وادٍ واحد? فأنت تقول: أعير الشيءُ اسمَه الموضوعَ له هنالك أي في
الإنسان - هاهنا - أي في الفرس -، لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه في جنسه، كما أعرت
الرجلَ اسم الأسد، لأنه شاركه في صفته الخاصّة به، وهي الشجاعة البليغة، وليس لليد
مع النعمة هذا الشبه، إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة، وكذا لا شَبَهَ ولا
جنسيةَ بين البعير ومَتَاعِ البيت، وبين المزادة وبين البعير، ولا بين العين وبين
جملة الشخص فإطلاق اسم الاستعارة عليه بعيدٌ. ولو كان اللفظ يستحقّ الوَصْف
بالاستعارة بمجرَّد النقل، لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام
بأنها مستعارة، فيقال: حَجَرٌ، مستعار في اسم الرجل، ولزم كذلك في الفعل المنقول
نحو: يزيد ويشكر وفي الصوت نحو: بَبَّة في قوله:واعتددت به في الجملة، ونبَّهت على
ضعف أمره بأن سمّيتُه استعارةً غير مُفيدة، وكان وزان ذلك وِزان أن يقال: المفعول
على ضربين مفعول صحيح، ومشبّه بالمفعول، فيُتجوَّز باعتداد المشبَّه بالمفعول في
الجملة، ثم يفصل بالوصف، ووجهُ شَبَهِ هذا النحو الذي هو نَقْلُ الشفة إلى موضع
الجحفلة بالاستعارة الحقيقية، لأنك تنقل الاسم إلى مجانسٍ له، ألا ترى أنّ المراد
بالشفة والجحفلة عضوٌ واحد، وإنما الفرق أنّ هذا من الفَرَس، وذاك من الإنسان،
والمجانسة والمشابهة من وادٍ واحد? فأنت تقول: أعير الشيءُ اسمَه الموضوعَ له هنالك
أي في الإنسان - هاهنا - أي في الفرس -، لأن أحدهما مثل صاحبه وشريكه في جنسه، كما
أعرت الرجلَ اسم الأسد، لأنه شاركه في صفته الخاصّة به، وهي الشجاعة البليغة، وليس
لليد مع النعمة هذا الشبه، إذ لا مجانسة بين الجارحة وبين النعمة، وكذا لا شَبَهَ
ولا جنسيةَ بين البعير ومَتَاعِ البيت، وبين المزادة وبين البعير، ولا بين العين
وبين جملة الشخص فإطلاق اسم الاستعارة عليه بعيدٌ. ولو كان اللفظ يستحقّ الوَصْف
بالاستعارة بمجرَّد النقل، لجاز أن توصف الأسماء المنقولة من الأجناس إلى الأعلام
بأنها مستعارة، فيقال: حَجَرٌ، مستعار في اسم الرجل، ولزم كذلك في الفعل المنقول
نحو: يزيد ويشكر وفي الصوت نحو: بَبَّة في قوله: لأُنْكِحَـنَّ
بَـبّـهْ جَارِيةً
خِــدَبَّة
مُكْرَمَةً
مُحـبَّـهْ تُجبُّ أهْلَ
الكعبَهْ
ويلوح هاهنا شيء، هو أنّا وإنْ جعلنا الاستعارة من صفة اللفظ فقلنا: اسم مستعارٌ،
وهذا اللفظ استعارةٌ هاهنا وحقيقةٌ هناك، فإنّا على ذلك نُشير بها إلى المعنى، من
حيث قصدنا باستعارة الاسم، أنْ نُثبِتَ أخصَّ معانيه للمستعار له، يدلّك على ذلك
قولنا: جعله أسداً وجعله بدراً وجعل للشمال يداً، فلولا أنّ استعارةَ الاسم للشيء
تتضمّن استعارةَ معناه له، لما كان هذا الكلام معنًى، لأن جَعَلَ، لا يصلح إلا حيث
يُرَاد إثبات صفة للشيء، كقولنا: جعله أميراً، وجعله لِصّاً، نريد أنه أثبت له
الإمارة واللصوصية، وحكمُ جَعَلَ إذا تعدَّى إلى مفعولين، حكم صَيَّرَ، فكما لا
تقول: ًصيَّرتُه أميراً إلا على معنى أنك أثبتَّ له صفة الإمارة، وكذلك لم تقل:
جعله أسداً إلا على أنه أثبت له معنًى من معاني الأسود، ولا يقال: جعلته زيداً،
بمعنى سمّيته زيداً، ولا يقال للرجل: اجعل ابنك زيداً بمعنى سَمِّهِ، ولا يقال:
وُلد لفلانٍ ابنٌ فجعله زيداً أي: سمّاه زيداً، وإنما يدخل الغلط في ذلك على من لا
يُحصِّل هذا الشأن، فأما قوله تعالى: "وَجَعَلُوا المَلاَئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ
عِبَادُ الرَّحْمنِ إنَاثاً" "الزخرف: 19"، فإنما جاء على الحقيقة التي وصفتُها،
وذلك أنهم أثبتوا للملائكة صفة الإناث، واعتقدوا وجودها فيهم، وعن هذا الاعتقاد
صَدَر عنهم ما صدَر من الاسم - أعني إطلاقَ اسم البنات، وليس المعنى أنهم وضعوا لها
لفظَ الإناث، أو لفظَ البناتِ، اسماً من غير اعتقادِ معنًى، وإثباتِ صفةِ، هذا
محالٌ لا يقوله عاقل - أوَ ما يسمعون قول اللَّه عز وجل: "أشَهِدُوا خَلْقَهُمْ
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْئَلُون" "الزخرف: 19"، فإن كانوا لم يزيدوا على
إجراء الاسم على الملائكة ولم يعتقدوا إثبات صفة ومعنًى، فأيُّ معنى لأن يقال:
أَشهدوا خلقهم هذا ولو كانوا لمَْ يقصدوا إثبات صفةٍ، ولم يفعلوا أكثر من أن
وَضَعُوا اسماً، لَمَا استحقُّوا إلاّ اليسيرَ من الذمّ، ولما كان هذا القولُ
كُفْراً منهم، والأَمرُ في ذلك أظهر من أن يخفى ولكن قَدْ يكون للشيء المستحيل
وجوهٌ في الاستحالة فتُذكَر كلُّها، وإن كان في الواحِد منها ما يُزيل الشُبْهة
ويُتمُّ الحُجَّةَ. | |
|